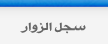الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ الحاجة إلى التأصيل التربوي للمصطلحات الشرعيَّة وأهميَّته
مقال شهر جمادى الأولى 1439هـ
الحاجة إلى التأصيل التربوي للمصطلحات الشرعيَّة وأهميَّته
الحمد لله الذي علَّم بالقلم ، علَّم الإنسان ما لم يعلم ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يُضْلله فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلَّغ الرسالة ، وأدَّى الأمانة ، ونصح الأمة ، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .. فقد استقرَّ في خلد المسلمين جميعاً ، أن الوحيين : الكتاب والسنة هما الأصلان الأساسان لكلِّ منطلقات الفرد والجماعة ، في كبار المسائل وصغارها ، فلا يعزب عنهما شيءٌ ممَّا تحتاج إليه الأمة لدينها ودنياها ، في أيِّ عصر ومصر ؛ بحيث يكون الوحي المنزَّل هو قاعدة العلم والعمل على وجه الدوام ، في كلِّ مناحي الحياة وميادينها وأنشطتها المختلفة والمتنوِّعة ، فلا يُستثنى من ذلك شيء .
ولقد اعتمدت أمة الإسلام الوحي المبارك : قاعدة أصيلة في مسيرتها الحضاريَّة الشاملة ، عبر قرونها المديدة ؛ فقد كانت النصوص الشرعيَّة المحكمة ، والأحكام الشرعيَّة المستنبطة ، والقواعد الفقهيَّة والأصوليَّة الضابطة ، وما لحق بها من علوم الآلة العلميَّة الأخرى ، كلُّ هذه المعارف والعلوم الأصيلة والرديفة : كانت وما تزال رفيقة المسيرة الحضاريَّة للأمة الإسلامية في غالب أطوارها ، لا سيما في عصورها الذهبيَّة ، وما ضعف عطاء الأمة المعرفي ، وخفت بريقها العلمي : إلا حين اختلَّت درجة ارتباطها بعلومها الأصيلة وآلاتها الضابطة ، فما زالت تتراجع في عطائها الحضاريِّ بقدر ذلك الاختلال ، فبعد أن كانت الأمة ملء السمع والبصر في كلِّ ميادين الحياة الإنسانيَّة : غدت - في عصورها المتأخِّرة - محصورة في زاوية ضيِّقة من الحضارة المعاصرة ، لا تكاد تُحسن شيئاً مما يُجيده الآخرون ، حتى الاقتباس الحضاري ، الذي يأتي أوَّل مهارات المُتخلِّفين المعاصرين ، والتي غالباً ما يُحسنونها ، فيُقلِّدون الآخرين فيما تُطيق حملَه عظامُهم الهشَّة ، ومع ذلك تتعثر الأمة في مسيرها الحديث ، في أسهل مُتطلَّبات الحياة المعاصرة ، ممَّا هو لصيقٌ بحاجات الناس اليوميَّة المعتادة ؛ في طعامهم وشرابهم ولباسهم ، وفي اتصالاتهم ومواصلاتهم ، وما جاء مخالفاً لهذا الوصف الواقعي فهو نادرٌ ، والنادر – عند العقلاء – لا حكم له .
وعند النظر في واقع الأمة المُتردَّي : يجد المتأمِّل أن الأزمة في أصلها وحقيقتها إنسانيَّة الطابع بالدرجة الأولى ، فكلُّ ما لحق الأمة من السوء بصورة عامَّة ، فقد سبق أن لحق الإنسانَ مثلُه بصورة خاصَّة ، فما تردَّت الأمة وهوت ، إلا بعد أن تردَّى إنسانُها وهوى ، فهو – دائماً – في كلِّ أمة ؛ إما أن يكون عنصر خيرها ، وإما أن يكون عنصر شرِّها ، ولهذا تحرص الأمم المتقدِّمة - في هذا العصر - على الإنسان بهذا الاعتبار ، فتعمل على بناء شخصيَّته ليكون عنصراً اجتماعيًّا نافعاً لأمته ، وذلك بقدر ما ادَّخرته - تلك الأمم - من خبراتها المعرفيَّة المُتراكمة ، وبقدر ما حفظته من ثقافاتها التراثيَّة المُتوارثة ، فبالمعرفة العلميَّة تتقدَّم الأمم ، وبالثقافة الموروثة تأْتلف وتتَّحد ، وبهما معاً تنهض وتستمر ، ويكون البناء الحضاري ثمرة لهذا التلاحم الضروري بين المعرفة العلميَّة والثقافة الأمميَّة .
والحالة الحضاريَّة عند الأمة الإسلاميَّة أبلغ من الحالة عند غيرهم ؛ فهم إنْ اتَّحدوا مع الآخرين في العنوانيْن : الثقافيِّ والمعرفيِّ ؛ فإنهم – بكلِّ حال – ينفردون عن الجميع في المضمون الثقافي ، وفي الهدف المعرفي ، ففي الوقت الذي ضلَّت جميع الأمم المعاصرة في ثقافاتها ، المتضمِّنة : لأديانها ، وعاداتها ، وتقاليدها ؛ فإن أمة الإسلام – في الجملة وعلى الدوام – مهتديةٌ في دينها ، مُعاذةٌ من الضلال العام ، لم يفتْها من دينها المُنزَّل قليلٌ ولا كثير ، حتى وإن لحقها شيءٌ من سَنَن مَن كان قبلها من الأمم السالفة ؛ فإنها دائماً مُتجدِّدة في كيانها ، مُتيقِّظة لفسادها ، مُتنبِّهة لضلالها ، لا يسري عليها ما يسري على غيرها ؛ فليس عند غيرها ما يرجعون إليه – عند التنازع - للاهتداء ، إلا ما خلَّفه رهبانهم وقساوستهم من الصحائف المحرَّفة ، أو ما تفوَّه به كُهَّانهم من الأهواء المُضلِّلة ، أو ما سطَّره فلاسفتُهم من الآراء المُحيِّرة ، وما كان من شيءٍ سوى ذلك ، فلا يعدو أن يكون جهوداً فرديَّة ، يزعم أصحابها الإصلاح ، وفق رؤاهم وتصوُّراتهم المُضطَّربة عن الكون والحياة والإنسان .
وأما انفراد أمة الإسلام عن غيرها من باقي الأمم في الهدف المعرفي ؛ ففي إدراج المعرفة بكلِّ تفصيلاتها ضمن مفهوم العبوديَّة لله تعالى ، فكلُّ نشاط علميٍّ صالح ، وأداء معرفي نافع ، واجتهاد عقليٍّ مُثمر ، يتعاطاه المسلم في مسيره الحضاري ؛ فإنه يُسجَّل له حسنات في صحائفه ، ويندرج ضمن مفهوم العبادة الشامل لكلِّ أعمال الإنسان الصالحة .
وهذا المفهوم التعبُّدي للهدف المعرفي من شأنه : ضبط مسيرة البشر الحضاريَّة بتوحيد غايتهم ، وفق مفهوم استخلاف الإنسان في الأرض ؛ إذ ليس للبشر المُستَخْلفين في الأرض أن ينِدُّوا عن نهج العبوديَّة لله تعالى ، فيختاروا لأنفسهم بين أن يعبدوا الله أو أن لا يعبدوه ، فضلاً عن أن يتخيَّروا لأنفسهم آلهة أخرى يعبدونها من دونه سبحانه .
وعلى إحكام الشعبتين معاً : الثقافيَّة والمعرفيَّة ، وصلاحهما من جهة المضمون والهدف : تبلغ الحضارة الإنسانيَّة مداها المُقدَّر دون انقطاع ، ويبقى عطاؤها الإنسانيُّ مستمرًّا دون اختلال ، فالبشريَّة باقيةٌ على هذا الحال الصالح من وعد ربِّهم تبارك وتعالى ، حتى يكون الخلل والتفريط من جهتهم ، والانقلاب والنكوص من قِبَلهم ، فلا وعد لهم حينئذٍ ولا أمان : ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) (14/6) .
وبناء على ما تقدَّم : تظهر أهميَّة تربية الإنسان لمهمَّة الاستخلاف في الأرض ، وفق الطيِّب الثقافيِّ والصالح المعرفيِّ ، كما تظهر أيضاً مركزيَّة الإنسان الصالح في مشروع البناء الحضاريِّ للأمة الإسلاميَّة ، ومن هنا يبرز الدور التربوي الرائد لمنهج التربية الإسلاميَّة ، وضرورته الحضاريَّة في بناء الإنسان الصالح ، الذي أناط به الخالق – جلَّ وعلا – مهمَّات الاستخلاف في الأرض ، وفق نهج هدايته ، وحسب سبيل سنَّته .
ووضْع هذا المنهج التربوي المنشود - لبناء إنسان الحضارة الصالح - لا يأتي من أوهام ثقافيَّة قاصرة ، ولا من آمال اجتماعيَّة زائفة ، ولا من خروص فكريَّة وافدة ؛ وإنما يأتي من عمق الثقافة الإسلامية وأصولها الدينيَّة المستنبطة من الوحي المبارك ، وإلا فكيف لمنهج الشرك أو الفسق أن يبني موحِّداً أو تقيًّا ؟! ومعلومٌ أن المنهج التربوي الأجنبيَّ : يُنتج إنساناً أجنبيًّا ، وكذلك المنهج المختلط بين هُويَّتين – هو الآخر – يُخرج وليداً قاصراً مشوَّه الشخصيَّة ، لا يصلح للبناء الحضاريِّ المتميِّز .
وغنيٌّ عن التنويه هنا إلى أن الْتقاط الحكمة الصحيحة عن الآخرين : هو من مقتضيات مفاهيم الإسلام الثقافيَّة وتفاعلاتها الحركيَّة ، ولكن هذا لا يجوز البدء به ما لم تستوفِ الأمة حقوق تراثها الثقافيِّ واستحقاقاته الواجبة أوَّلاً ، قبل أن تنظر إلى ما عند غيرها ، فإن العاقَّ لذويه لن يبرَّ الآخرين ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : لا بدَّ أن تمتلك الأمة المنهج الراشد لمهارات الاقتباس الحضاري، وذلك قبل أن تخوض تجارب الآخرين وثقافاتهم .
ثم هذا الذي تجرَّأ بالاقتباس من ثقافات الآخرين وتراثهم : بأي منهج تُراه يأخذ عنهم ؟ فإن بعض الموتورين من المتغرِّبين : لا يرى بأساً في أن يأخذ عنهم كلَّ شيءٍ يجده ، حتى ما اتفق عليه العقلاء أنه ساقط ، بل إن الباحث الدقيق يعجز أن يجد في بعض كتبهم وأبحاثهم المنشورة : لفظ الجلالة المعظَّم ، واسم الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم- فضلاً عن أن يجد الآية من القرآن ، أو الحديث من السنة ، باعتبار أن التربية عندهم شيءٌ آخر غير الدين ، بل إن أحدهم يتحاشى في تعبيراته كلمة الإسلام في وصف البلاد العربيَّة ، فيستخدم كلَّ مفردة لغويَّة أوتيها على أن يصف العرب بالإسلام ، فمثل هؤلاء العميان التائهين : إذا قُدِّر أن أُسندت إليهم مسئوليَّات الاقتباس التربوي عن الآخرين ، فماذا تُراهم يُخرِجون لأمتهم من المناهج التربويَّة ؟!
ومن زعم منهم أنه يمتلك منهجاً مُتقناً للأخذ عن الآخرين من غير أهل الملَّة : فليُبْرزه للتقويم إن كان صادقاً ، فإن الذي لا يُفرِّق – من هؤلاء - بين التوحيد والشرك ، ولا يُميِّز بين الوحي والرأي ، ولا يعرف معنىً لاستخلاف الإنسان في الأرض ، ولا يفهم هدفاً للأمانة التي حمَّله الله تعالى إيَّاها ، ولا يراعي حتميَّة معاده في الآخرة ، فمثل هذا كيف يسوغ للأمة أن تأمنه على وضع منهج تربيتها ؟ فإن طريق الاقتباس محفوفةٌ بالمخاطر العقديَّة والأخلاقيَّة ، إضافة إلى ما يُتوقَّع من الاختلالات الفكريَّة - بسبب المنهج الوافد - في بناء الشخصيَّة الإسلامية المنشودة ، التي يزعم هؤلاء المقتبسون أنهم يتجاوزونها بأساليبهم الخاصَّة ، وبما يدَّعونه لأنفسهم من خبرات ومهارات علميَّة ومعرفيَّة ، تخوِّلهم حقَّ الأخذ عن غير أهل الإسلام .
ولقد شهد الواقع القريب زيف دعاوى هؤلاء وخروصهم ؛ فقد أُوتوا الفرصة التربويَّة تلو الأخرى ، وملَكوا بالفعل زمام مؤسسات التربية ومراكزها في العالم الإسلامي الحديث عقوداً من الزمان : إدارة ، وتأليفاً ، وتنظيراً ، فما زادوا الأمة – في أزماتها التربويَّة - إلا خبالاً ، رغم أن مَن كانوا من الأمم في شرق آسيا وجنوبها في حضيضٍ حضاريٍّ إلى عهد قريب : تجاوزا المسلمين اليوم بمراحل ، فلن يكون من الحكمة أن يُمكَّن هؤلاء من جديد بعد كلِّ هذا الإخفاق ، وقد خابت مساعيهم ، وظهر للناس عوارهم ؛ في حين أن الواجب الآن المتعيِّن شرعاً : هو التقويم لما سلف من جهودهم ، وفق المعايير الشرعيَّة والعلميَّة .
إن أمل الإصلاح التربوي في العالم الإسلامي : معقودٌ على منهج التربية الإسلامية وحده ، فلا يُنازعه دخيلٌ في مكانه وموضعه من مؤسسات التربية ، فهو منهجٌ ربَّانيٌّ لا يقبل الشرْكة في أصوله ومبادئه ، ولا في منطلقاته وأهدافه ، يستلهم تراث الأمة الثقافيَّ وينطلق منه ، ويفهم الواقع الحضاريَّ ويُراعيه ، فيجمع بكفاءة بين الأصالة والمعاصرة ، ويفرِّق – في اختياراته التربوية – بين الثابت والمتغيِّر ، ويعرف - تماماً – ما يُقتبس عن الآخرين وما لا يُقتبس ، فهو منهج تربويٌّ راشد بكلِّ المعايير .
ومع كلِّ هذا ، فإن هذا المنهج المنشود : لا يعمل من تلقاء نفسه ؛ لا في بنائه ولا في أدائه ، وإنما هو ثمرة جهد الإنسان المُجتهد ، الذي يعيش خضوع العبوديَّة لخالقه جلَّ وعلا ، فلا يتجاوز في بنائه لهذا المنهج معالم دينه ، ولا يتعدَّى في أدائه حدود شرعه ، فهو في نطاق العبوديَّة في البناء والأداء .
وهذا يقتضي بالضرورة استيعاب المنهج للمعالم الدينيَّة الكبرى ، التي يقوم عليها البناء الإسلامي ، فيما يتعلَّق بمفهومي : الإسلام والإيمان ، وما ترمي إليه الشريعة من حفظ المقاصد الخمسة الضروريَّة : الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال ، وما يلحق بذلك من خارطة العلوم الإسلاميَّة ، وما يتبع ذلك من المفاهيم العلميَّة والاصطلاحيَّة ، التي غالباً ما تشكِّل عائقاً علميًّا للباحثين التربويين ، عندما يتعاطون مع هذه العلوم ، فيصطدمون بمصطلحات شرعيَّة وأخرى لغويَّة ، لم يسبق لهم التعرُّف عليها في مراحلهم الدراسيَّة السابقة ، ولهذا كثيراً ما يُحْجم الباحثون التربويُّون عن خوض مفازة المصطلحات الشرعيَّة ، باختيارهم موضوعات تربويَّة غير تأصيليَّة ، خوفاً من الخطأ الشرعي ، وإيثاراً للسلامة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : رغبة بعضهم في الدعة ، وتجنُّب التحدي البحثي ، الذي يتكلَّف فيه الباحث – عادة - أضعافاً من الأداء العلمي ، ويُكابد فيه مزيداً من الإرهاق النفسي ، ويتحمَّل كثيراً من الجهد الذهني ، فرغم إحْجام كثير من الباحثين عن خوض تجربة هذا النوع من المعاناة العلميَّة ، فإنهم – بإحْجامهم هذا – يُفوِّتون على أنفسهم تجارب : علمية ، ونفسية ، وذهنيَّة ، لا يمكن لهم اكتسابها في غير هذا السبيل ؛ فإن المعاناة البحثيَّة وصعوباتها المُتنوِّعة : جزءٌ أصيلٌ في بناء شخصيَّة الباحث ، وقاعدة مهمَّةٌ في إعداده لحياة علميَّة واعدة .
إن من أهم مهمَّات منهج التربية الإسلاميَّة في هذا العصر : هو تذليل السبل الكفيلة بدخول الباحثين التربويين إلى مختلف العلوم الشرعيَّة ؛ ليتمكَّنوا من الجمع بكفاءة بين التربية والشرع ، في ضوء ما يُسمَّى بالبحوث البينيَّة ، وهذا لا يتأتى إلا بالبدء الجاد في التأصيل التربوي للمصطلحات الشرعيَّة ؛ بحيث يُعرَّف المصطلح الشرعي تعريفاً تربويًّا يفهمه التربويُّون ، مع الإبقاء على اسم المصطلح ورسمه ، حتى لا يستهجنه الشرعيُّون ، ومن ثمَّ يُصنَّف المصطلح تصنيفاً تربويًّا ، ضمن مجالات التربية وحقولها وفروعها المتعدِّدة : الإيمانيَّة ، والتعبديَّة ، والأخلاقيَّة ، والاجتماعيَّة ، العقليَّة ، والجسميَّة ، الاقتصاديَّة ، والمهنيَّة ، والسياسيَّة ، والجماليَّة ، والفنيَّة ، والبيئية ، ونحوها من المجالات التربويَّة الكثيرة ، فيُخرَّج المصطلح الشرعي تخريجاً تربويًّا قابلاً للتصنيف التربوي ، ممَّا يُمكِّن الباحثين ويسهِّل عليهم خوض التجربة البحثيَّة في العلوم الشرعيَّة ، وفق معالم ومجالات التربية وحقولها المتنوِّعة ، ممَّا يُهيئ للباحثين بيئة علميَّة خصبة لبحوث جديدة رائدة ، ويفتح لهم آفاقاً علميَّة واسعة ومتجدِّدة .
ولعلَّ في ضرب المثال ما يُوضِّح المقصود بالتأصيل التربوي للمصطلح الشرعي ؛ ففي مصطلح : ( اللُّقَطَة ) عند اللغويين : هو من الالتقاط ، وهو الأخذ والتناول ، وهو عند الشرعيين في الاصطلاح : مالٌ محترم يجده الإنسان ضائعاً في الطريق ، سواء كان نقداً ، أو شيئاً ممَّا له قيمة ماليَّة ، ولا يُعلم صاحبه ، فمن وجده من المارَّة ، وعزم على أخذه : أُلزم بمعرفته وحفظه ، فهو أمانةٌ عنده ، وعليه الإعلان عنه ، وتعريفه مدَّة سنة ، وتسليمه لصاحبه إن حضر ، وإلا فهو بعد ذلك أحقُّ بالاستمتاع به ، وفق ضوابط ذكرها الفقهاء ، فهذا المصطلح إذا قُدِّم للتربويين على هذا النحو اللغوي والشرعي ، فلن يجدوا له موضعاً تربويًّا ، ولكن إذا قُدِّم المُصطلح بأبعاده التربوية : اختلف الأمر عندهم ؛ فاللُّقَطة قيمةٌ ماليَّةٌ مُعرَّضةٌ للضياع ، فهي من جهة حفظها : تنميةٌ في بعدها الاقتصادي ، وبحيازتها ورعايتها ، ومن ثمَّ تسليمها لأهلها : أمانة في بعدها الأخلاقي ، وبالإعلان عنها ، والبحث عن صاحبها : صلةٌ في بعدها الاجتماعي ، وهكذا يدخل المصطلح الشرعي في صلب المسألة التربويَّة ، فإذا أُخذت طائفة من هذه المصطلحات ، وفق هذا التأصيل التربوي أو نحوه : انفتحت أبوابٌ واسعة من المعرفة العلميَّة ، طالما كانت موصودة في وجوه التربويين .
وبهذه الخطوة الضروريَّة تُقام الجسور الرابطة بين التربية والشريعة ، فيسهل على السالكين التردُّد بيسر بين التخصُّصين ، وهذا من شأنه - إن تمَّ على هذا النحو – أن يمنع من استمرار الأميَّة الشرعيَّة عند التربويين ، الذين ابتُليَ جمهورهم بها ، فإذا رافقت هذا المشروع مجموعة من المقرَّرات المنهجيَّة لطلاب التربية الإسلاميَّة ، في مهارات البحث في العلوم الشرعيَّة وفنونها : كان من تكامل هذين الأمرين خروج أبحاث علميَّة تأصيليَّة ، تُوطِّد الصلة وتقوِّيها بين المجالين : الشرعي والتربوي ، فيقوم التزاوج بينهما في نهجٍ علميٍّ متكامل ، وتُردم بذلك الهوَّة بينهما ، فينتج عقب هذا التزاوج : منهج التربية الإسلامية المنشود ، الذي عقدت عليه الأمة الإسلامية أملها في النهضة ، وقد رسخ تربويًّا أنه إذا صحَّت المُدخلات التربويَّة : صحَّت بقدر ذلك مُخرجاتها .