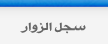الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ العَورةُ الخُلُقيَّة
مقال شهر صفر 1439هـ
العَورةُ الخُلُقيَّة
الحمد لله الواحد الأحد ، والصلاة والسلام على خير من خلق ، نبيِّنا وسيِّدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد .. فرغم حجم الانتهاكات السلوكيَّة ، والتجاوزات الأخلاقيَّة ، التي يُعاينها النُّقاد الاجتماعيون في جانب العورة الجسديَّة : فما زال السلوك الإنساني – في مجمل المجتمعات الحضاريَّة - يحترم ستْر العورة ، ويُولي الخصوصيَّة الشخصيَّة – في هذا الجانب – تقديراً عاماً ، وَفق ما يعتقده المجتمع من الحدود المُحرَّمة للعورة الجسديَّة .
غير أن ما حظيت به الأجساد من معاني الحُرمة – على ما فيه من الاضطراب والإخفاق المُخْجل – ظلَّت الأخلاق الاجتماعيَّة قابعةً في أحطِّ دركات التعاطي الإنساني ، حتى عاد السقوط الأخلاقي المدوِّي والمُتكرِّر عند الرجل : صغائر مُغتفرة ، ولم يعد للفضيحة الخُلقيَّة وقعها المُفزع على المجتمع ، بعد أن اتَّسعت ساحة الانتهاكات السلوكيَّة وتكرَّرت ، وكثرت العثرات الأخلاقيَّة وتعدَّدت ، وتجاسر الجمهور على الوقاحات ، واقْتحموا قائمة من الحماقات ، حتى كادت تبلغ الجميع ، فلا يكاد يُستثنى أحد من المزالق السلوكيَّة المُخْجلة ، وإنما يتفاوتون في حجم لوثاتهم الخُلقيَّة ؛ فمنهم من يتخفَّى مُستتراً بلوثته الصغيرة ، فتبدوَ للعَيان أحياناً ، وتغيب أحياناً أخرى ، ومنهم من لوثته ظاهرةٌ بادية ، تذهب معه حيث ذهب ، وتحلُّ معه حيث حلَّ ، فلا يكترث لبدوِّها ، ومنهم – والعياذ بالله تعالى – من يجرُّها خلف ظهره جرًّا ، يتقدَّمها تارة ، وتتقدَّمه تارة ، فيتعثَّر بها في مسيره ، وتتعثَّر به في انحدارها !!
وهذا الوضع الاجتماعيُّ الشائع أدَّى : إلى تعارف الناس على قبول بعضهم بعضاً ، بكلِّ عيوبهم وسواقِطِهم ، على قاعدة : افْتضحوا فاصْطَلحوا ، لا يعرفون معروفاً ، ولا يُنكرون مُنكراً ، إلا ما كان مشوباً بهوى ، ثم بقيَ الصالحون وحدهم في زاوية ضيِّقة من حياة المجتمع ، يُكافحون ما لحق بهم في أنفسهم ، من كشف عوراتهم الخلقيَّة ، ويُعالجون لوثاتهم المَرَضيَّة ، ويُقاومون التآكل الأخلاقي لا يُصيبهم ، ويُدافعون الزحف الاجتماعي لا ينالهم ، وقد قلَّ على طريقهم الوعرة السالكون ، وكثر – في مقابل ذلك – المُخالفون ، ولهذا تُساورهم رهبة السقوط ، وتُخيفهم عواقب الأمور ، فقد أحاطت بهم غُمَّةٌ قاتمةٌ حالكةٌ ، ولفَّهم سواد ليل مُظْلم دامس ، من السوءات الخلقيَّة المكشوفة ، والرعُونات السلوكيَّة المفْضوحة ، التي تفرض نفسها على الجميع ، فلا تسمح لكريم النفس بالعيش السوي ، فضلاً عن أن تسمح له بالانفراد السلوكي ، أو الشموخ الخُلُقي ، ممَّا يُعسِّر مهماتهم التربويَّة ، ويُقلِّل من نجاحاتهم الميدانيَّة ، سواء كان ذلك تجاه أنفسهم بحفظها من الذوبان ، أو تجاه الآخرين بإعانتهم على أنفسهم ؛ فإن أخوف ما يخافه كريم الخُلُق : أن ينكفئ على نفسه ليحفظها من فساد يُحاصرها ، فينشغل بنفسه عمَّن سواه ، فينطلق يُغلق دونها أبواب الحرام ، ويكفُّ عنها مداخل الفساد ، فلا يعود له شغلٌ إلا حفظ نفسه ، قد تنكَّر له كلُّ شيء ، فما بقيَ يعرف إلا نفسه .
وفي مثل هذا الخضمِّ الصعب : يُكافح المغمومُ ليبقى كريماً بين البخلاء ، ويجاهد ليبقى شريفاً بين الحُقراء ، ويُنافح ليبقى مُحترماً بين السفهاء ، ويُقاوم ليبقى عزيزاً بين الأذلاء ، فإن من الناس من يعيش كبيراً ، ويموت كبيراً ، لا يرضى لنفسه الكريمة إلا العلوَ بالحقِّ ، قد تشوَّقت روحه للمعالي ، وتشوَّفت نفسه للكمال ، في مقابل من يعيش صغيراً ، ويموت صغيراً ، قد رضيَ لنفسه الوضيعة بأدنى المقامات ، بنحو ما يُؤْنس العجماوات ، من الأولويَّات البدائيَّة الفسْيولوجيَّة ، وصدق الشاعر إذ يقول :
على قدْر أهْل العَزْم تأتي العَزائمُ وَتأتي علَى قدْرِ الكِرامِ المَكارمُ
وتَعْظُمُ في عَين الصَّغير صغارُها وتصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ
وإن أسوأ ما يَلْحق الصالحين : أن يضطرَّ أحدهم لسقْطة أخلاقيَّة ، لا يجد عنها مناصاً ولا محيداً ، فإذا تلبَّس بها - ولو مرَّة - عَسُر عليه غسْلها ، فتبقى كدَمةً في صفحته الخُلقيَّة ، وشجَّةً في بنائه النفسي ، وعورة في حياته الاجتماعيَّة ، فهي في حسِّه الخُلقيِّ : أعظم ألف مرَّة من انكشاف سوْأته الجسديَّة ، فهذه لا تلبث إلا يسيراً ، حتى تُمْحى من الذاكرة الاجتماعيَّة ، أما تلك فلا كفَّارة لها ؛ فإن المجتمع – بطريقة عفويَّة – لا يتسامح مع القدوة حين تسْقط ، ولو كانت مُضْطرَّة لواحدة في العُمر ؛ لأن ما يُنتظر منها اجتماعيًّا : أكبر بكثير ممَّا تظنُّ ، فلا يتحمَّل المجتمع من قدواته – لا سيما رموزه الكبار – خطأً ما ، يُشوِّش في عقولهم صورَهم الذهنيَّة ، ويُعكِّر في نفوسهم مقاماتهم الاجتماعيَّة ، التي سبق أن ارتسمت في مُخيَّلات أبناء المجتمع ، ورسخت في أذهانهم ، عبر عقود مُتعاقبة من الزمان .
ورغم ما يحمله هذا السلوك الاجتماعي - تجاه القدوة الأخلاقيَّة - من القسوة والصرامة والحدَّة : فإنه - مع ذلك - من أجلِّ الحوافز النفسيَّة للصالحين ، ومن أعظم الكوابح الأخلاقيَّة للمربيِّن ؛ حين يعمل المجتمع – بطريقته العفويَّة الخاصَّة - على تخْليص قدواته من السواقط الخلُقيَّة ، ويحميهم من المزالق السلوكيَّة ، فيبقوْا شامخين على عهودهم الاجتماعيَّة المعلومة ، لا تشوبهم شوائب المجتمع ، ولا تُدنِّسهم رعوناته الأخلاقيَّة ، فهم دائماً عند حسْن ظنِّ الجميع ، حتى إن أرذل الناس : لا يقبل من الشريف إلا أن يبقى شريفاً دائماً ، ولا يرضى للإمام إلا أن يكون في الأمام أبداً ، فلا يلين المجتمع مع رموزه في الترخُّص برخص العوامِّ ، ولذا يُلجئهم إلى مسلك القدوة إلْجاءً ، ويضطرُّهم إلى مقام النُّبل اضْطراراً .
ولهذا انتفع الإمام أحمد بن حنبل في سجنه بسارق ساقط ، في زمن محنة القوْل بخلق القرآن ، حين حثَّه على الثبات على الحقِّ ، فلم يرضَ له مقاماً دون العزيمة ، في مقابل ثبات السارق – نفسه - على الباطل ، فكان ذلك حافزاً مؤيِّداً للإمام أحمد ، على أن يأخذ بالأعلى من المهمَّات ، التي انفرد بها عن جمهور علماء عصره ، وهكذا المجتمع الإسلامي في كلِّ عصر – مهما بدا فيه من التفريط والتقْصير – فإنه لا يقبل من المُحسن إلا الإحسان ، ولا يرضى لرموزه إلا العزيمة ، فهو – وإن لم يسلك مسالكهم – فإنه يرى نفسَه فيهم ، فكلُّ إنجازٍ لهم : يراه المُجتمع إنجازاً له ، كما أن كلَّ سقوطٍ منهم : هو سقوطٌ للمجتمع بأكمله ، ولهذا يسعد المُجتمع بغلَبتهم ، ويحزن لهزيمتهم ، ويرتاح لعلوِّهم ، ويضْجر لهبوطهم .
ولا يخالف هذه المشاعر الإسلاميَّة إلا منافق مُنْدس ، قد مرَد على النفاق ، فلا يُسعده ثبات الصالحين ، ولا يُؤنسه مقام المتَّقين ، ولا يُتْحفه تعاطف المسلمين ، فهو كالأرَضة ينْخر المجتمع من داخله ؛ فيذيع السوء ويستر الحسن ، ينشر الباطل ويكبت الحقَّ ، فهو كائنٌ خارج المسلك الاجتماعيِّ العام ، ليس هو من الناس في شيء ، غير أنه متيقِّظٌ لعورات المجتمع ، ثم هو أيضاً مُنتبهٌ لمقَاتِله المُميتة ، فإذا حانت الفرصة المُواتية ، وتهيَّأت الظروف المُناسبة : انقضَّ على مواضع الوجع من المجتمع ، ونزل بثقله على المفاصل الرخوة منه ، فهو دليلٌ أمينٌ لكلِّ عدوٍّ غاشم ، وعينٌ خائنة لكلِّ كافر آثم ، وكما قال الشاعر :
إن الكريمة ينْصرُ الكرمَ ابنُها وابن اللئيمةِ للئام نصور
والغريب أن السذَّج من أبناء المجتمع ، يعيشون بأحلام المراهقين ، ويُغرِّدون بأصوات العصافير ؛ فيأملون الخير في المُنافقين ، ويرجون البرَّ في الكافرين ، وهم يرون بأعينهم سوءاتهم الخُلُقيَّة بادية للعيان ، ظاهرة لا تخفى على العميان ، عبر تاريخهم القديم والحديث ، ضمن مواقف مُخزية كثيرة ومُتكرِّرة ، من أسافل الأخلاق وأحطِّها ، ممَّا يعجز الواصف البليغ عن وصفه ، فهم دائماً وعلى مرِّ العصور : ( لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً...) (9/10) ، وإنما طريقتهم الوقحة في تسويق باطلهم على السذَّج : (... يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ...) (9/8) ، فالكلام الأجوف هو حدُّهم مع من يقبل منهم ، والتصريح الأخرق هو نهجهم لمن يُصدِّقهم بكذبهم ، من سفهاء الناس ، ممَّن يعجزون عن فهم المُحْكمات القرآنيَّة ، فلا يستوعبون المُحكم الصريح من التنزيل المبارك ، القاطع في شأن هؤلاء ، فقد جمع الله تعالى لنبيِّه محمدٍ – صلى الله عليه وسلم – كلا الفئتين : المُنافقة والكافرة ، لينفض يديه الشريفتين منهما جميعاً ، ويقطع الأمل فيهما معاً ، فقال - جلَّ مِن قائل - : ( وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ) (33/48) ، فالله تعالى كافٍ من كلِّ شيء ، ومُغْنٍ عن كلِّ أحد ، ولذا يُلفت نبيَّه الكريم – صلى الله عليه وسلم - إلى كنز النصر والفلاح : (...هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) (8/62) ، ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (8/64) .
إنها لفتةٌ ربانيَّةٌ ضروريَّة ، يحتاج إليها الصالحون المُصلحون ، حتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان في حاجة إلى أن يُذكِّره الله تعالى بها ، فهم ليسوا وحدهم منْفردين في غياهب الظلُمات الاجتماعيَّة ، ولا منسيين في دروب الحياة في أيِّ زمن ؛ فإن الحضور الإلهي العظيم ، بمعيَّة الحفظ والنصر والتأييد : شاهدٌٌ قائمٌ دائمٌ ، يشعر بذلك المؤمنون ، فلم تغبْ معيَّته – سبحانه وتعالى - عن أوليائه قطُّ ، ولن تغيب عنهم أبداً ، لا سيما في أشدِّ الأزمنة خوفاً وحرجاً : (...لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ) (20/46) ، وإنما الذي ينقص الصالحين – في بعض الأحيان – هو استحضارهم الحيَّ للمعيَّة الإلهيَّة ، في تعاطيهم مع ضغوط الحياة الاجتماعيَّة من حولهم ، وفي كفاحهم المُستميت لحفظ أخلاقهم من الذبول ، وفي سعيهم الحثيث للحدِّ من تفاقم الانحرافات السلوكيَّة ، فهم دائماً في كنف المولى - جلَّ وعلا – يتلمَّسون لطفه ورحمته بهم ، في كلِّ خطوة يخْطونها ، وفي كلِّ اجتهاد يتخذونه .
إن المجتمع المسلم بكلِّ أفراده : صالحهم وطالحهم ، عالمهم وجاهلهم ، بلا استثناء ولا تمييز : مدعوون إلى التوبة من ذنب أو تقصير ، كما قال الله تعالى : (...وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ...) (24/31) ، كلُّهم في حاجة ملحَّة إلى عطْفةٍ خُلُقيَّة صادقة ، تُلْجم جموح النفس ورغباتها ، وتضبط نوازع الشهوة وأهوائها ، فما زال الربُّ الكريم : توَّاباً رحيماً ، لكلِّ من عاد إليه تائباً مُنيباً ، فهذا شأن العبيد : يُذنبون ويخطئون ، ثم يعودون تائبين مُنيبين ؛ فليس لهم - في شأن سلوكهم - أن يختاروا لأنفسهم بين الاستقامة أو الانحراف ، ما داموا مؤمنين ، ففرقٌ كبير بين من يُذنب ويسْتغفر ، ومن يُذنب ويسْتكبر ، فالأول ينتظر من الله الرحمة ، والآخر ينتظر المقْت : ( إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ) (39/41) .