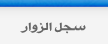الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ الحدُّ الفاصل بين الخير والشر
مقال شهر ذي الحجة 1438هـ
الحدُّ الفاصل بين الخير والشر
الحمد لله تعالى وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، نبيِّنا وقائدنا وقدوتنا : محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ، أما بعد .. فقد تختلط على بعض الناس الحدود المنطقيَّة الفاصلة بين الخير والشرِّ ؛ فيظنُّ أن لكلٍ من الخير والشرِّ حدٌ ينتهي إليه ، فالخير في تصوُّره الذهنِّي قائم بحده ، والشرُّ أيضاً قائمٌ بحدِّه ، فلا يختلطان ولا يتداخلان .
ولهذا تنقسم أحكام هذا الصنف من الناس إلى قسمين ، لا ثالث لهما ؛ فإما أن يحكم بالخير مُطْلقاً ، أو أن يحكم بالشرِّ مُطْلقاً ، فإذا تقارب الخير والشرُّ في أمر من أمور الحياة – كما هو واقعٌ طبيعيٌّ – سواء في شخصٍ ، أو موقفٍ ، أو فكرٍ ، أو سلوكٍ ؛ فإن هذا المُختَلِط لا بدَّ أن يحكم على هذا الأمر بواحدٍ من النقيضين ، حسبما يبدو له الأمر من وجهة نظره وفهمه ، فهو لا يرى في الشيء إلا لوناً واحداً ، فلا يُمكنه أن يرى في الأمر - المعروض عليه - لوناً آخر ، مهما كان اللَّون الآخر واضحاً جليًّا .
ومن هنا يُلْحظ على هذا الصنف من الناس – في أحكامه – أنه مُتفائلٌ للغاية ، كما أنه مُتشائمٌ للغاية أيضاً ؛ وذلك حين يُطْلق حكمه على أمر ما بالخير ، رغم ما يتضمَّنه هذا الأمر من كثير من الشر ، أو يحكم على الأمر الآخر بالشرِّ ، رغم ما يبدو معه من الخير ، وهكذا حتى يخلص في أحكامه إلى فسطاطين مُتناقضين ، أحدهما من الخير والآخر من الشر .
في حين أن العاقل من الناس يملكه – في العادة – الصراع ، وتدخله الحيْرة ، عند حكمه على كثير من مُتغيِّرات الحياة ومواقفها المختلفة ؛ فيتنازعه – في حكمه - طرفا الخير والشرِّ ، حتى إنه ربَّما توقفَّ في الحكم لقوَّة التنازع بين الطرفين ، فلا يُسارع في إطلاق حكْمه ، إلا بعد استيفاء جميع عناصر الموقف وجوانبه ، وإلا آثر السلامة بالتوقُّف ، خشية المسبَّة والعار ، اللذيْن يلْحقان بالمستَخَفِّين من الناس ، ممَّن يتقاحمون الصعاب بلا بصيرة .
والصحيح المُستفيض عند جماهير العقلاء من كلِّ نحْلةٍ وملَّة : أن التداخل بين الخير والشرِّ أمر واقع عام ، لا يُنكره إلا من استخفَّ نفسه ، من الخُدَّج ضعفاء العقول ، ممَّن لم يتمُّ لهم تمام النضج الفكري ، الذي يُؤهَّلهم لسلامة النظر ، ومن ثمَّ يُعينهم – بعد توفيق الله تعالى - على سداد الحكم ؛ ومن هذا الباب جاء الشرع الحنيف بذمِّ الغلوِّ والغلاة من عُمْيان البشر ، الذين لا يعقلون ولا يفهمون ، فلا يُبصرون - في كلِّ ما حولهم - إلا لونين مُتنافريْن ، فقد عميت أبصارهم عن كلِّ خير مشوبٍ بشر ، وعن كلِّ شرٍّ مشوبٍ بخير .
ولهذا يحكم هؤلاء وأضرابهم على أنفسهم وما يهْوونه بالخير ، ويحكمون على غيرهم وما يكْرهونه بالشرِّ ، حتى إن من فرط غلوِّهم يُزكُّون أنفسهم غاية التزكية ، كما كانت الخوارج تزعم ، فينْسبون لأنفسهم كلَّ خير ، وينْفون عنها كلَّ شر ، إذ الشرُّ عندهم هو الكفْر ، ولهذا يدَّعون الكمال والتَّمام ، ويرمون الآخرين بالنقائص والآثام ، حتى إن من عظيم فتنتهم بأنفسهم ، ودعوى خُلُوصهم من الشرِّ كلِّه : رموْا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بالكفْر ، في الوقت الذي لم يُرْموْ هم به ، وهم أحقُّ به من الصحابة رضوان الله عليهم .
وهذا ما يُلْحظ أيضاً في الغلاة من الطرف الآخر ؛ ممَّن يُسمَّون أنفسهم باللبراليين الأحرار ، ممَّن يدَّعون الكمال العقلي والخلقي والنفسي ، ويرمون الآخرين بنقيض ذلك من السفه والقبح والشذوذ النفسي ، حتى إنهم من فرط غلوِّهم في أنفسهم : لا يرون خيراً في مصلٍّ ولا مُستقيم ، حتى يوافق أنماط أهوائهم ، وربَّما جعلوا مرتبة المؤمن من الناس دون مرتبة الكافر الأصلي ، وهكذا الغلوُّ – متى وُجد - انحاز – في الطرفين - إلى الأقصى منهما ؛ لأنهم لا يفهمون من الأحكام إلا هذيْن .
ولو تحرَّر كلُّ فريقٍ من داعية الهوى ، وأمعن في نفسه وأحوالها ، وأعاد النظر في الآخرين وأحوالهم ، ثم راجع الهدى في آيات التنزيل المبارك : لتبيَّن له خطأ نهجه في ضلال حُكمه ، فليست ذاته بأشْرف الذوات ، ولا عقله بأنضج العقول ، ولا نفسه بأزكى النفوس ، بل هو خلْقٌ مُبتلى من خلق الله تعالى ، يجري عليه ما يجري على غيره ، ويصدق عليه ما يصدق على الآخرين ، فالكلُّ مذنبٌ خطَّاء ، وإنما ينْبل من المذنبين الخطَّائين : من كان منهم أقلُّ خطأً ، وأقوم مسْلَكاً ، وأقرب إلى الصواب الشرعي ، وليس النبيل من الناس - في الشرع - هو المعصوم ؛ فإن العصمة خصوصيَّة نبويَّة ، وإنما النبيل من الناس : مَن قلَّت معايبه ، وعُدَّت عليه مساقِطه ، ومن زعم – من الناس - الكمال : فهو إلى النقص أقرب ، وبالخطأ أحرى ، وبالعيب أولى ، ولا يدَّعي الكمال إلا الغلاة من الطرفين المذمومين .
ولهذا لا ينفرد الخير عن الشرِّ بصورة مُطْلقة ، حتى يتمحَّض كلٌّ منهما في ناحية ، وإنما يتخالطان ويتغالبان ، حتى يطفو – على الشخصيَّة - الغالب منهما ويعمُّ ، ومع ذلك لا يُجيز الشرع إنكار الخير وإن قلَّ ، ولا الغضُّ عن الشرِّ وإن ندر ؛ فإنما هي موازين العدل الإلهي ، التي تتقبَّل وزن مثاقيل الذرِّ من الخير أو الشرِّ ، كما قال عزَّ وجلَّ : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) (99/7-8) ، فكلاهما – من الخير والشرِّ – معتبرٌ بالشرع ، لا يفوت اللطيف الخبير شيءٌ من ذلك وإن قلَّ ، ولهذا لا يحكم - الصادق في إيمانه - على الأمور كلِّها ، إلا بما حكم الله تعالى فيها ، وقد حكم الله تعالى وقضى أنه يحتسب للعبد المؤمن ذرَّاته من الحسنات ، حتى ما تفوته – سبحانه – واحدة منها ، كما وعد بذلك : (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ) (21/47) ، فحريٌّ بالعبد الصادق احتساب ذلك الخير في الآخرين ، فإن فاتته ملاحظة مثاقيل الذرِّ فيهم ؛ لعجزه عن إدراك ذلك ، فلا عذر له فيما بان واستفاض من الخير ؛ فإن أقلَّ حسنة معتبرة عند الله تعالى : ما يُعلنه المسلم من الشهادة بالتوحيد ، بقوله : لا إله إلا الله ، فمن أتى بها : فقد أتى بحسنة معتبرة ، تأذن له في وزن أعماله : خيرها وشرِّها ، فهو بين الكفَّتين لا يُظلم شيئاً ، فلا تُحبط سيئاتُه حسناتِه ، كما هو حال الكفَّار ، الذين لا يُقام لهم يوم القيامة وزناً ، فمن لم يعتبر بمثل هذا - من الغلاة المُتطرِّفين - فقد أعظم على الله تعالى الفرية .
وبناء على هذا الأصل : جاءت الشريعة الخاتمة بوجوب العمل على تكثير المنافع وإن قلَّت ، وتقليل المفاسد وإن كثُرت ، ما أمكن إلى ذلك سبيلاً ، فما كان من خير عُمل عليه وأُكْثر منه ، وما كان من شرٍّ دُفع وقُلِّل منه ، وأقلُّ الخير الذي يُبْنى عليه ، ويُعمل على تكثيره : هو التوحيد أصل الإيمان ، فقد تُحيط بالموحِّد ظلمات الكبائر والفواحش ، وتُثقله آثام المعاصي والذنوب ، ومع ذلك يُعتبر توحيده ، ما دام سليماً من الشرك الأكبر ، حتى وإن كان وزن توحيده قدر ذرَّة أو أقلَّ منها ، فثواب التوحيد لن يفوت العبد مهما بلغ فجوره ، فلا بدَّ أن تبلغه الرحمة عاجلاً أو آجلاً ؛ فإن من أقرَّ لله تعالى بالتوحيد ، ليس كمن جحده وكفر به .
ومثل هذا اللُّطف بالموحِّدين : حريٌّ بالمقوِّم اعتبار أمثاله ، لا سيما ما كان واضحاً من الخير ، فلا يُهْضمُ صاحبه حقَّه من ذلك ، كما أن الشرَّ لا يُغضُّ الطرف عنه ، وإن كان يسيراً ، وإنما تكون محصِّلة الحكم للغالب من الحاليْن ، ولو كانت محصلة الحكم لا تجوز إلا على التَّمام من أحد الحاليْن : لم يُحكم لأحد بالإسلام حتى يأتي بكلِّ التكاليف على التَّمام ، وهذا بعيد في الطبيعة الإنسانيَّة ، فلم يدَّعِ الأولياء الصادقون قطُّ استكمال شعب الإيمان ؛ ولهذا يتورَّعون عن وصف أنفسهم بالإيمان ، وما منهم من أحد إلا وهو يخشى على نفسه ألا يوافي القيامة مؤمناً ، ولا يدَّعي كمال الإيمان ، وموافاة القيامة به : إلا جريٌ مُبْطلٌ .
إن الحدَّ الفاصل بين الخير والشرِّ ، والتباعد البيِّن بينهما : لا يحصل تمامه إلا يوم القيامة ، بعد أن يخلص الموحِّدون جميعاً من النار ، فلا يبقى فيها أحد أخلص لله تعالى في توحيده ، ممَّن قضى الله تعالى عقوبتهم بالنار ، فإذا تمايز القوم بعضهم عن بعض ، وانزاح الفريقان ، كلٌّ في داره ومثواه الأخير : (...فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ) (42/7) ، هنا يتمحَّض الخير والشر ، ويتميَّز كلٌّ منهما عن الآخر ، فيخلص الخير في الجنة دار السلام ، ويخلص الشرُّ في النار دار الشقاء ، فهذا هو مُنتهى الحدِّ الفاصل بين الخير والشر .