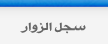الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ نقد طاغوت العلمانيَّة
مقال شهر شعبان 1438هـ
نقد طاغوت العلمانيَّة
الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيِّدنا رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد .. فإن الصبغة الربَّانية للشخصيَّة الإسلامية : تتغلغل في كلِّ مفاصل وجزئيات حياة الإنسان ، فلا يفوتها منه باطنٌ من : اعتقاد ، أو نيَّة ، أو إرادة ، أو خاطر ، أو هاجس ، ولا يفوتها منه أيضاً ظاهرٌ من : قول ، أو فعل ، أو سلوك ، فكلُّ ذلك مشْمولٌ بصبغة الله تعالى ؛ بحيث يخلُص العبد كلُّه لله تعالى ، فلا يبقى منه حظٌّ للنفس أو الشيطان : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) (51/56) .
إن تصوُّر هذا الشمول ، على هذا النحو المُطْبق على الكيان الإنساني بأجمعه ؛ بحيث لا يفوت منه معنويٌّ ولا مادي : لن يكون قبوله مستهجناً على العقل البشريِّ إن هو تأمل وتدبَّر ؛ فإن مُقتضى الملك - في عُرف الناس - يقتضي حقَّ المالك في التصرُّف الكامل فيما يملك ، والله تعالى يقول في كتابه عن شمول ملكه في الإنسان : ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) (37/96) ، فالذي خلق الإنسان كياناً ، وخلق تصرُّفاته وأفعاله الإراديَّة والعفويَّة سلوكاً : لا بدَّ أنه مالكٌ لكلِّ ذلك قطعاً ؛ إذ ليس في الوجود إلا خالقٌ ومخلوق ؛ خالقٌ له مطْلق الكمال التَّام بلا مُنازع ، ومخلوقٌ ناقصٌ قاصرٌ ضعيفٌ ، يستمدُّ بقاءه من صاحب البقاء المطْلق سبحانه وتعالى ، وهذا يقتضي أن لا يكون في الوجود إلا ربٌّ ومرْبوبٌ ؛ ربٌّ واحدٌ يُنشئ عبيده من عدم ، ثم يتولاهم بإحسانه وفضله ، ويكْلؤهم برعايته ورحمته ، ومربوبٌ فقيرٌ مُعوز ، مُحتاجٌ إلى ربِّه – بصورة دائمة مطْلقة - في جميع شأنه ، وفي كلِّ وقته .
وهذا الواقع الكونيُّ – بالضرورة - يستلزم في نهاية المطاف : أن لا يكون في الوجود إلا إلهٌ واحد معبود ، وكلُّ ما سواه – سبحانه - عبيدٌ يتألَّهونه ، إما بإرادتهم واختيارهم ، وإما بقهْره وجبْره إيَّاهم ، وسلطانه التَّام عليهم ، فيشملهم ذلك جميعاً ؛ سواءً العاقل منهم أو البهيم ، الماديُّ أو المعنوي ، الساكن أو المُتحرِّك ، الحيُّ أو الميِّت ، لا يشذ عن ذلك شيء في الوجود : من كبير أو صغير ، عظيم أو حقير : (...وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) (10/61) . إذا تقرَّر هذا : كان الله – جلَّ وعلا – وما زال هو وحده المُستحقُّ للعبادة الخالصة ؛ وذلك لخلْقه وقهْره ، وفضله وإحسانه ، وتمام مُلكه وسلطانه ، فهذه مقْتضيات الملك ، التي مُنع منها كلُّ مخْلوق ؛ إذ لا تنبغي إلا لواحد ، أحد ، صمد ، قادر : (...وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (5/17) ، فليس في الوجود شيء خارجٌ عن ملكه وإرادته وجبروته : ( إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ) (19/93) ، فليس للمخلوق مع خالقه – جلَّ جلاله – إلا مقام العبوديَّة وحده ، يتزكَّى به ويصلح ، ويتشرَّفُ به وينبُل ، أو له الأخرى الحقيرة : مهْبط الكبْر والعُجب والإباء : يُذلُّ بذلك ، وينْحطُّ به ويخْنس ، كحال اللعين الأول : ( قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا...) (7/18) .
إذا استقرَّ هذا الفهم ، عن شمول ملكه – سبحانه – لكلِّ الموجودات ؛ لكونه خالِقُها ومُوجدها : فإن مقتضى هذا الملك ، وأهم مستلزماته ، وأخصُّ خصائصه ، هو حقُّه – تبارك وتعالى - في الأمر ، المُتضمِّن حقَّ التشريع للعبيد ، وإلْزامهم بأنواع التكاليف المختلفة ، فيقول - جلَّ وعلا – جامعاً بينهما : (...أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) (7/54) ، فلا يكون أبداً خلْقٌ بلا أمر ؛ إذ يستحيل في العرف والعادة أن ينفصل حقُّ المُلك عن حقِّ التصرُّف ، فهُما قرينان لا ينفصلان ، وكذلك في الجانب الآخر – كما هو مفروضٌ شرعاً - لا يكون أمرٌ بلا مُلْك ؛ إذ لا بدَّ للآمر بأمره أن يكون خالقاً لمُلكه ، وهذا مُستحيلٌ على العبيد المخْلوقين ، فلا يكون إلا لمالك الملك وحده سبحانه وتعالى .
وبناء على ذلك ، فإذا تصرَّف المخْلوق بأمر نفسه - سواء في ذاته أو في غيره - إنما يغتصب حقَّ الخالق وحده في الانفراد بالأمر ، ولهذا دائماً ما يدَّعي الطاغوت الألوهيَّةَ من أجل الأمر والنهي ، ولا يدَّعي الربوبيَّة لعجزه البيِّن عن الخلْق ، فما زال الطواغيت - في القديم والحديث - تستعبدون الناس قهْراً بالطاعة والإذعان لتشريعاتهم ، ولكن يخسأ أحدهم حين يروم تعبيدهم بحقِّ خلْقِه إيَّاهم .
ورغم وضوح الفرق الجليِّ ، بين من يخلُق ومن لا يخلُق : ( أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ) (16/17) ؛ فإن عمى البصيرة قد ينْزل بالمبْصرين ، فتخْتلط عليهم صفات الخالِق العظيم ، بصفات المخلُوق الأثيم ، فيخْلعون على الطواغيت من صفات الألوهيَّة والربوبيَّة : ما لا يجوز إلا للخالِق وحده جلَّ وعلا ، فينطلقون يأمرون وينْهون من عند أنفسهم ، ويُحلِّون ويُحرِّمون بأهوائهم ، فيتبوَّأ الطاغوت - من خلال اغتصابه حقَّ التشريع - مقام الخالِق – سبحانه - صاحب الأمر ، فلا يجد المُسْتعبدون الأذلاء ، إلا الإقرار للطاغوت بألوهيَّته عليهم : ( وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ...) (7/127) ، وفي قراءة : ( وإلاهتك ) ، قال أهل اللغة : (الإلاهة : العبادة ؛ فالمعنى : يذرُك وعبادة الناس إيَّاك ) (زاد المسير لابن الجوزي 3/244) ، وقال الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن (3/1353) : ( إن فرعون لم يكن يدَّعي الألوهيَّة ؛ بمعنى أنه خالِق هذا الكون ومُدبِّره ، أو أن له سلطاناً في عالم الأسباب الكونيَّة ، إنما كان يدَّعي الألوهيَّة على شعبه المُسْتذل ؛ بمعنى أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه...وهذا ما يدَّعيه كلُّ حاكم يحكم بشريعته وقانونه ) ، فإعطاء حقِّ الطاعة المُطْلقة لمخلوقٍ ، يحكم بهوى نفسه ، بغير هدىً من الله تعالى : فهذه عبادةٌ له ، حتى وإنْ ادَّعى – العابد والمعبود – غير ذلك : ( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ...) (9/31) ، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم – رضي الله عنه – في طاعة النصارى المطْلقة لرهبانهم ؛ يُحلِّون ويُحرِّمون حسب أهوائهم : (...فتلك عبادتكم إيَّاهم ) ؛ إذ ليس مفهوم العبادة قاصراً على مظاهر الذل البدني ؛ من ركوع وسجود وانكسار ، بل هو أشمل من هذا ، وربَّما أخطر منه ، حين يستوي الخالقُ والمخلُوقُ - في حقِّ التشريع - في حسِّ الإنسان ، فلا يُفرِّق بين مَن له حقُّ التشريع المطْلق بمقتضى الملك ، وبين مغتصبٍ فاجر ، يدَّعي الألوهيَّة لنفسه على الناس .
وهذه تسْوية مرفوضةٌ حسًّا ومعنىً ، ومع ذلك يقول بها العُميان – رغبةً أو رهبةً – حتى إذا وَافُوا القيامة بضلال عبادتهم : برُّوا في قسمهم على ضلالهم ، وصدقوا في حَلِفِهم على شرْكهم : ( قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ، إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) (26/96-98) ، فكيف خفيَ - على هؤلاء الضُّلال - فساد هذه التسوية المقيتة ؟ وهم يشاهدون قصور طواغيتهم البيِّن عن مطْلق الخلْق : (...إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ...) (22/73) ، ثم هم بعد هذا العجْز الفاضح عن مطْلق الخلْق - ولو كان في شأن أحْقر الكائنات - هم أيضاً عاجزون - ولا بدَّ - عن مقْتضاه من المُلك : (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ) (34/22) ، فلا هم يخلقون ، ولا هم يملكون ، فكيف لمثلهم أن يتألَّه على من دونه من الناس ؟!
إنهم لا يتمكَّنون من ركوب رقاب الناس ، وإخضاع نفوسهم وشُخُوصهم ، إلا حين يفقد الواحد منهم إنسانيَّته ، وتنحطُّ نفسه وكرامته ، فتتعطَّل قدراته العقليَّة ومداركه ، التي تُميِّزه عن البهيمة العجماء ، التي لا تُفرِّق بين من يمْتطيها من الراكبين ؛ فقد يركبها نبيٌّ مُرسل ، وقد يركبها شقيٌّ مُبْطل ، بل إن بعض الأشقياء : ليلْتذ بالذل والمهانة ، لذة العزيز بالحريَّة والكرامة ، وهذا من أعجب ما يكون من بني آدم : ( وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) (39/45) ، فما يكون فيه عزُّ أحدهم بالتوحيد والحريَّة : يستبدله بما فيه ذلُّه ومهانته من الشرك والعبوديَّة ، قال الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن (5/3055) على مفهوم هذه الآية : ( فمن الناس من تشمئزُّ قلوبهم ، وتنْقبض نفوسهم ، كلَّما دُعوا إلى الله وحده إلهاً ، وإلى شريعة الله وحدها قانوناً ، وإلى منهج الله وحده نظاماً ، حتى إذا ذكرت المناهج الأرضيَّة ، والنظم الأرضيَّة ، والشرائع الأرضيَّة : هشُّوا وبشُّوا ، ورحَّبوا بالحديث ، وفتحوا صدورهم للأخذ والردِّ ) .
إن هذا التأصيل العقدي للمسألة التشريعيَّة في نظام الحكم الإسلامي - على هذا النحو - يدحض الفكرة العلمانيَّة من جذورها ، ويقْتلع قضيَّتها من أصولها ، فلا يبقى لها مستندٌ ترجع إليه ، ولا حجَّةٌ تركن إليها ، فما يُحاول أن يلوكه العلمانيُّون من مسوِّغات فصل الدين – الذي هو إرادة الله الشرعيَّة من عبيده – عن معترك الحياة العامة : هو في حقيقته لا يعدو أن يكون محاولةً بائسةً يائسةً ، لاقْتطاع جزء من ملك الله تعالى العتيد ، واغتصاب طائفة من سلطانه المجيد ، ليكون في يد طاغوت حقير مريد ؛ إذ الكلُّ يعلم أن دعوى فصل إرادة الله الدينيَّة عن الحياة بأكملها ، أو حتى عن جزء يسير منها : هي دعوةٌ كاذبة في جوهرها ومضمونها ؛ لأن من لا يملك نفسه ، ولا يخلق فعله : هو قطعاً لا يملك غيره ، ولا يصنع فعله ، فكيف ساغ لمن دونه موافقته على مشروعه الآثم ، في فصل مراد الله تعالى الشرعيِّ – صاحب الخلْق و الأمر - عن طائفة من مناشط الحياة الإنسانيَّة ، فضلاً عن الاستبعاد الكامل لشرع الله تعالى المنزَّل .
إن الطاغوت العلماني لا يحتاج إلى تبرير جريمة طغيانه واغتصابه ، فهو يتلذذ بالسلطة على الأغبياء ، ويتنعَّم بالترأس على السفهاء ، فعلامَ يتحرَّج المستفيد من طُغيانه ؟ وإنما العجب كلُّ العجب ممَّن يستلذ مسْتمْتعاً بالهوان ، ويرضى خانعاً للطغيان ، وهو في كلِّ هذا خاسرٌ بكلِّ حال ، وإنما حظُّه من الذل والهوان : أن يذوب مُحترقاً لأنس غيره بلا مقابل : (وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ، قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ) (40/47-48) ، فهذه هي - وربِّ الكعبة – الخسارة الكبرى ؛ إذ ليس وراء خسارة حظوظ الآخرة أكبر منها : (...قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ) (39/15) .
إن ممَّا ينبغي أن يُستوعب من خطر الفكرة العلمانيَّة : أن اغتصاب حقِّ الله تعالى في يسير السلطة التشريعيَّة ، كالاغتصاب في كثيرها ، فكلاهما جريمة لا تُغتفر ، فاستباحة اليسير من حقِّ الله تعالى في التشريع والسلطة ، كاستباحة الكثير منه ؛ إذ لا يحتاج الطاغوت لولوج الكفر الأكبر : أن يُخالف مُسْتحِلاً كلَّ الشرع المُحكم المُتفق عليه ، بل إن واحدة من ضروريَّات الدين المعلومة المشهورة للعامة والخاصَّة : تكْفيه للدرك الأسفل من النار .
ولئن كان الكفر بعضه أشدُّ من بعض ، والإثم بعضه أكبر من بعض ، وجهنَّم طبقاتٌ ودركات ، ومع ذلك فالنار مثواهم جميعاً : (...إِنَّا كُلٌّ فِيهَا...) ، فأقلُّهم عذاباً من له نعلان من نار ، يغلي منهما دماغه ، لا يرى أن أحداً أشدُّ منه عذاباً ! فما أغنى عن الطاغوت العلمانيِّ قليل كفره ، وقد حُبس في النار مع أئمة الكفْر ؟ فالذنب الأكبر قد حبس الجميع ، إلا أن يكون بعضهم أشدُّ عذاباً من بعض : (قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ) (7/38) .
إن العبيد المكلَّفين لا يجوز لهم أن يُزاحموا إرادة الله تعالى الشرعيَّة في قليل ولا كثير ممَّا بلَّغتهم به الرسل ، فليس لهم في ذلك إلا الطاعة ظاهراً وباطناً ، تماماً كما أنهم كلُّهم لا يزاحمونه – سبحانه – في شيءٍ من إرادته الكونيَّة القاهرة ، فهم إن كانوا عاجزين عن التأثير في شيء من مُجْريات الكون وأسبابه ، فإنهم كذلك عاجزين عن التشريع لأنفسهم ، في قليل شأنهم وكثيره ، فلا مدخل للفكرة العلمانيَّة ، في محاولة فصل جزء من الحياة عن سلطان الله تعالى التشريعي ، تحت أيِّ اعتبار من : تحديث ، أو تطوير ، أو تجديد ؛ لأن الحكمة الربَّانية في الرسالة المحمديَّة الخاتمة : قد استوعبت تماماً جميع الثوابت والمُتغيِّرات ، فلم يعْزب عن اللطيف الخبير – جلَّ وعلا – صغيرٌ ولا كبيرٌ من حاجات وتحسينيَّات عباده التشريعيَّة ، فضلاً عن رعايته – سبحانه تعالى – لضروريَّاتهم التي لا بدَّ لهم منها ، فالقصور الشرعي الذي يحكيه طاغوت العلمانيَّة ، ويرمي به الوحيَّ المُنزَّل قبل قرون ، هو عين قصور قدرته - في ذاته الحقيرة – عن الملك ، فضلاً عن الخلْق ، فمن لا يخلُق لا يملك ، من لا يملك لا يحكم : (...ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ) (35/13) ، فمن لا يملِك قشْرةً رقيقةً من نواة مهملة ، فماذا تُراه يملِك فوق ذلك ليحكم فيه ؟!