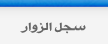الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ واقع حقوق الطفل في ظلِّ حماية منظَّمة الأمم المتَّحدة
مقال شهر رجب 1438هـ
واقع حقوق الطفل في ظلِّ حماية منظَّمة الأمم المتَّحدة
الحمد لله الذي خلق فسوَّى ، والذي قدَّر فهدى ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضْلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، خير هادٍ إلى الهدى ، وأفضل مرْشد إلى التُّقى ، بلَّغ رسالة ربِّه ، وأدَّى أمانة دينه ، ثم ترك أمته على أفضل ما يُمكن أن تكون عليه ، وأسدى إليهم أحسن ما كان من نبيٍّ لأمته ، فصلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده أجمعين .. أما بعد فإن انطلاق الحديث عن حقوق الطفل ، منذ منتصف القرن العشرين الميلادي ، مع ولادة منظَّمة الأمم المتحدة ، بعد انتهاء حقْبة ما يُسمَّى بعصبة الأمم ، وخروج دول العالم بوثائق متعدِّدة ، تتضمَّن حُزمة من المواد الحقوقيَّة ، التي يجب أن يتمتَّع بها طفل الدول المنْضوية في المنظَّمة ، فمنذ ذلك الحين - وقد تجاوز صدور هذه الوثائق منْتصف العقد الثاني من الألفيَّة الثالثة – لم يتمتَّع غالب أطفال هذه الدول بحقوقهم المقرَّرة ، على الوجه المُسطَّر في هذه الوثائق الموقَّع عليها من جميع مندوبي دول المنظَّمة ، وإنما انحصرت جُلُّ منافع الأطفال الحقوقيَّة : ضمن اجتهادات الدول المتقدِّمة والغنيَّة ، حسب رؤاهم واختياراتهم ، وفق مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسيَّة .
وعلى الرغم من تعدُّد المؤتمرات والندوات : العالميَّة والإقليميَّة والمحليَّة ، التي تولَّتها المنظَّمة منذ ذلك الحين - بطريق مباشرة أو غير مباشرة – لتفعيل وثائق حقوق الطفل ، وتحريك آليَّاتها التطبيقيَّة ، ومتابعة الدول الموقَّعة في ذلك : لم يحظَ الطفل – في العموم – بكثير ولا بقليل ، مما كان تحقيقُه مأمولاً من هذه الدول ، بل إن الواقع العالمي في العموم ، وما يُسمَّى بالعالم الثالث على الخصوص : شهد تراجعاً خطيراً ، وانحداراً ذريعاً ، وهبوطاً سحيقاً في حقِّ الطفل ، فوق ما كانت المنظَّمة تأمل – في ذلك الزمن - رفعه من المظالم والآصار ، فكانت الفاجعة في حقِّه أكبر ، والأزمة عليه أعنف ، ونسب الانتهاكات الحقوقيَّة أوسع وأشمل ، على عكس ما كانت المنظَّمة تهدف – على فرض أن القائمين والمقرِّين كانوا صادقين في تبنِّيهم للمقرَّرات المُعلنة - ولا يُستثنى من هذا الإخفاق بلدٌ من البلدان ، فعلى الكلِّ سُجِّلت ووُثقت وقائع متنوِّعة ضدَّ الطفل ، تزيد أحياناً وتنقص أحياناً أخرى ، حسب درجة الضبط الأمني في ذلك البلد ، ودرجة الوعي الخُلُقي لدى أهله ، وسلطة الاعتقادات الدينيَّة عليهم ، وحجم الرفاهية الاقتصاديَّة التي يعيشونها .
بل ربَّما انعدمت حقوق الطفل تماماً في بعض الأمصار المعاصرة ، حتى غدا حقِّه في البقاء حيًّا بلا طعامٍ ولا مأوىً : هدفاً مأمولاً ، تُطالب به المنظَّمات الإغاثيَّة : العالميَّة والمحليَّة ، في دول ما أُطلق عليها : دول الربيع العربي ، فقد أصبح الطفل الصغير – فضلاً عن الشيخ الهرم والمرأة العجوز – جزءاً من أدوات الصراع الحربيَّة القذرة ، التي تستخدمها الدول الكبيرة المُستعمِرة ، وأذرعها المحلَّية والإقليميَّة المُجْرمة ، لتحقيق مكاسب سياسيَّة وطائفيَّة ضيِّقة ، فتستهدف بآلتها الحربيَّة المُحرقة : كلَّ حيٍّ وميت ، وشجرٍ وحجر ، ضمن طاحونة الحرب المدويَّة ، التي لا ترحم أحداً من المدنيين ، فضلاً عن أن ترحم الرجال المُقاتلين .
والمتابع لما جرى في حقِّ الطفل – ما زال يجري – من الفتك والتدمير والتهجير - في هذه الحقبة التاريخيَّة البائسة – يتأكَّد لديه الاعتقاد الجازم بإبطال العمل بهذه الوثائق ، التي انحصر دورها - في هذا العصر - في الدعائيَّة الإعلاميَّة المُنمَّقة ؛ فالوقائع الإجراميَّة الموثقة بالصورة والصوت والمُوضع : قد أجهزت على البقيَّة الباقية من دعاوى حقوق الإنسان بعامَّة ، وحقوق الطفل بخاصَّة ، بل قد أتت - هذه الوقائع - على مسوِّغ وجود المنظَّمة الأمميَّة من أصله ؛ إذ لم يعد لوجودها – ولا للمنظِّمات والهيئات التابعة لها - معنىً تسند إليه ، بعد أن أخفقت في الواجبات الأصلية ، التي قامت من أجلها ، فكما انتهت حقبة عُصبة الأمم في العقود الأولى من مطلع القرن العشرين ، بسبب تعثُّراتها المُتكرِّرة ، في مهمَّاتها السياسيَّة والأمنيَّة ، فكذلك الشأن مع هذه المنظَّمة الشائخة ، التي لم يعد لوجودها مسوِّغ سياسي أو أخلاقي أو إغاثي ، إلا ما يُشرْعِن للفجَّار المُتنفِّذين قبيح صنيعهم ، وعظيم تجاوزاتهم في حقِّ الإنسانية ؛ فتمدُّهم بالتشريع القانوني ، وتحوطُهم بالمظلَّة الدوليَّة ، في الوقت الذي تكفُّ فيه المُتظلِّمين عن مجرَّد الشكوى ، فضلاً عن إقرارها حقَّهم في ردِّ المُتسلِّط المعتدي ، أو دفع المارد الصائل ، التي تأتي أولويَّة سياسيَّة وأمنيَّة ، ضمن الأسس والمهمَّات الأصلية لعمل المنظَّمة وأدائها ، مما تضمَّنته بنود الوثائق الأساسيَّة الأوليَّة وموادها التفصيليَّة ، التي صدرت مع ولادة المنظَّمة ، وما لحقها بعد ذلك تِباعاً من مُقرَّرات وبنود أخرى أصيلة ، دخلت بالضرورة ضمن عملها وواجباتها الدوليَّة ، فإن الأصل الأول في مشروعيَّة وجودها : إحقاق الحقِّ ، وردِّ الظلم ، وكفِّ المنازعات المسلَّحة ، والعمل على المصالحات السياسيَّة ، إضافة إلى حقِّها المشروع ، في استخدام القوَّة العسكريَّة ، لتحقيق هذه المقاصد النبيلة .
إن هذه المرحلة التاريخيَّة البغيضة من عمر منظَّمة الأمم المتحدة : سوف تبقى وصمة عار في وجه الأمم الشاهدة ، وحكوماتها الموقِّعة والمُقرَّة ، تلحقهم جميعاً بقدر حجم تفريطهم وتقصيرهم في حقِّ الإنسان ، بل إن لعنة الظلم والتآمر والتواطؤ : سوف تنال كلَّ مجرم شارك بإسهامٍ ما ؛ في : ظلمٍ ، أو دعمٍ ، أو فتوى ، في هذه الجرائم الإنسانيَّة البشعة ، التي كانت المنظَّمة - وما تزال - شاهدة عيان عليها ، وسوف يتحمَّل المجتمع الدولي بأكمله ، سواء منهم : المُتآمر الماكر ، أو المنفِّذ الآثم ، أو الساكت الأخرس ، فالكلُّ سوف يتحمَّل قسطاً ما ، من تبعات هذه المآسي البشريَّة المُتراكمة في مُستقْبل الحياة ، تطال الجميع بلا تمييز ولا تفريق ، في صورٍ من الرفض السياسيِّ العنيف ، والتمرُّد الشبابيِّ الشديد ، والسخْط الاجتماعيِّ الحاد ، مما سوف يبدو بارزاً في سلوك جيلٍ الأزمة وطِباعِهم ، التي بنتْها - في نفوسهم – القسوة والظلم والبؤس ، وغذتها المؤامرات المحليَّة والإقليميَّة ، وأكَّدها لديهم التواطؤ الدولي على مقدَّراتهم ومصالحهم ، في أيسر حقوقهم المتَّفق عليها بلا نزاع .
إن الإنسان هو الإنسان ، كما خلقه الله تعالى على فطْرته الأولى : حُرًّا عزيزاً صالحاً ، يأبى الظلم والاضطهاد ، ويرفض التسلُّط والاستبْداد ، فإذا خالطت فطرته النقيَّة لوثات الانحراف والفساد ، وداخلت نفسه مظالم العنف والاستبداد ، وحاصرته الحاجات المُلحَّة والضروريَّات : فإنه – حينئذٍ - لا يُسأل عمَّا قد يصدر عنه من حجم العنف والغلو والشطط ، فإن الغضب - في السلوك الاجتماعي المعتاد – كثيراً ما يخرج بصاحبه عن المألوف الخُلُقي ، فيأتي الغضوب بما لا يُستحسن من السلوك القبيح الأرعن ، فكيف تُراها تكون شخصيَّة من فُتك بأسرته وداره ومتاعه ، فلم يبقَ له شيءٌ ممَّا يُبهج الإنسان في الحياة ؟ فأيُّ سلوكٍ يمكن أن يُعبِّر عن حجم سخطه وغضبه ، تجاه من فتك به ؟ وتعظم أزمة المجتمع الدولي حين يكثُر المضطَّهدون ، وقد تراكمت مآسيهم وتشابهت ، فيكون منهم تيَّار بشريٌّ جارف ، لا يُميِّز – في كثير من الأحيان – بين الصديق والعدو ، بل ربَّما – من فرض الغضب والأسى – توجَّه الشخص المُغْلق بالانتقام نحو الذات ، حين لا يجد - سواها - مُتنفَّساً لعظيم حنقه وانتقامه .
إن الوصول بالإنسان إلى هذه المرحلة القاسية من التوتُّر والإغلاق، وانْسداد أفق الأمل : له تبعات اجتماعيَّة واقتصادية وسياسية خطيرة ، لا سيما إذا وجد المتأزِّمون صيغاً فكريَّة تُؤطِّرهم ، ومسلكاً سياسيًّا يجمعهم ، ضمن تيَّار جماعيٍّ يرفع راية الخلاص والانتقام ، وفق رؤىً صلبة حادَّة الزوايا ، لا تتقبَّل قريباً لا يُوافقها ، فضلاً عن عدوٍّ يتجهَّمها ، حينها تتحمَّل المجتمعات قاطبة – رغماً عنها – ما قد يصدر عن هذه الفئات المأْزومة ، التي نشأت مظلومة مقهورة محْرومة ، في ظلِّ مجتمع دوليٍّ غشوم ، لا يرحم الضعيف ، ولا يلين للمسكين ، ولا يعطف على الصغير .
إن من المعيب على مجتمعات اليوم : أن يدخل ألفيَّتها الميلاديَّة الثالثة ، محمَّلة بكلِّ هذه المآسي الإنسانيَّة البغيضة ، بجانب ما حقَّقته من الإنجازات الحضاريَّة الكبرى ؛ في العمارة والاتصال والمواصلات وغيرها ، فتجمع - في مسيرها الحضاري المعاصر - بين المُتناقضات الصارخة ، التي يستحيل - عند العقلاء - الجمع بينها في باب من أبواب الحياة ، إلا حين يتنكَّب - إنسان العصر المظْلم - بوصلته الإنسانيَّة ، وطبيعته البشريَّة ، فيغدو مسيره في الحياة مُنكبًّا على وجهه ، فلا يُبصر – من أبعاد النظر وجهاته المتعدِّدة - أبعد من موضع قدميه : ( أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (67/22) .