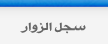الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ مع القرآن
مقال شهر ذي القعدة 1437هـ
مع القرآن
الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيراً ، يهدي به الله من يشاء من أوليائه ، ويضلُّ عنه من يشاء من أعدائه ، فيشرح به صدور من أراد هدايتهم ، ويُضيِّق به صدور من أراد غوايتهم ، فيسعد به المؤمنون ، ويشقى به الكافرون ، فلا إله إلا هو الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الإله الحقُّ المبين ، والصلاة والسلام الأتـمَّان الأكْملان على المبعوث بالقرآن ، رحمة وهدى للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .. فإنه ما من نبيٍّ أرسله الله تعالى إلى قوم إلا وآتاه من الآيات المعْجزات ، والبراهين الساطعات ، ما يؤيِّد دعوته ، ويُعلي مكانته ، وعلى مثل هذا يُؤمن الناس ، ويتَّبعون الرسل .
ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بدْعاً من الرسل ، فقد آتاه الله تعالى من الآيات والمعجزات نحواً مما آتى غيره من المرسلين ، غير أنه زاد عليهم بمعجزة فريدة باهرة ، لم تكن قطُّ لغيره من الأنبياء ، فكانت معجزة بيانيَّة ساحرة ، منظومة على نهج لغويٍّ فريد ، لا يشبه كلام البشر ، ولا يستطيع معارضته أحد ، رغم أنه منظوم من أحرف عربية ، يتكلَّم به أفصح الناس ، ومع ذلك لا يقدر على مثله ، أو على بعضه أحدٌ منهم ، وأعجب من ذلك استعصاؤه على الزوال ، فما يزال باقياً ما بقيَ الإنسان ، حتى يأذن الله تعالى برفعه في آخر الدهر ، فقد باءت كلُّ وسائل محوه ، أو إتلافه ، أو تحريفه ، أو إبعاده : بالإخفاق والتعثـُّر ، وما زال القرآن على حاله كما أنزله الله تعالى .
وإن من الحقائق العظيمة الكبرى ، التي قد تغيب عن وعي المسلم : أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى ، وهذا يعني أنه ليس عند البشر شيء يُوصف بأنه غير مخلوق إلا القرآن ، فهو مِن عِلْم الله تعالى وأمْره ، فقد فرَّق – سبحانه - بين خلْقه وأمْره ، فقال : (...أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ...) (7/54) ، وهذا يستلزم من المكلَّف الوعي بهذا الفارق العظيم ، والبون الواسع الشاسع الكبير ، بين كلام البشر : ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) (37/96) ، وبين كلام الرِّب جلَّ وعلا : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ...) (9/6) ، فهذا الفارق العظيم بين الكلاميْن ، لا يمكن أن يقدَّر بحجم أو وصف ، فهو فارق فوق قدرات البشر ليصفوه على حقيقته ، كمن يروم وصف الفرق بين الخالق والمخلوق ، فكذلك الفرق هنا بين كلامه – سبحانه وتعالى – وكلام غيره من المخْلوقين .
وهذا الفهم العقدي للقرآن الكريم ، لا بدَّ أن يستحضره المتدبِّر وهو يعالج آياته ، ويستشعر في نفسه عظمته ، فلا تغيب عن عقله ونفسه مشاعر العظمة ، التي من شأنها بلوغ مقاصد القرآن في أهله ؛ من التقديس ، والتعظيم ، والإجلال ، ومن ثمَّ الفهم والتطبيق ، غير أن واقع غالب الناس لا يبلغ هذا القدر من الاستحضار الذهني لهذا الفارق العظيم الجليل ، بين كلام الله تعالى وكلام البشر ، فما زال الأعم الأغلب من المسلمين يتعاملون في حدِّ التبرُّك والتعوُّذ ، وأجر القراءة ، ولكن لو قامت في نفس المؤمن هذه المشاعر ، أو قريباً منها : لكان لوقْع القرآن على النفوس شأنٌ آخر ، ولبلغت أمة الإسلام مداها الأعظم من العلم والعمل ، ولتحقَّق لها موعودها بالنصر والتمكين ، كما سبق للأمة في عصور ماضية .
وهذا القدر من الوعي بهذه الخاصيَّة القرآنيَّة الجليلة ، لو قُدِّر للمكلَّف استحضاره ، فانكشف له يسيرٌ من الوعي بهذا الفارق : لوقع له من هيبة القرآن وإجلاله ، ما لا يمكنه معه من دوام العيش على نحو ما يعيشه الناس ، فإن فاته مثل هذا الاستحضار الفريد ، فلا يصحُّ أن يفوته – على الأقل - القدر الواجب من الاعتقاد بهذه الخاصيَّة الفريدة لهذا الكتاب المُقدَّس .
ومن هنا ، فالقرآن كلام الله تعالى ، قد تكلَّم به الربُّ الكريم ، فتلقَّاه الملَك صاحب الوحي الأمين ، فنزل به تِباعاً على قلب سيد المرسلين ، فما أن ينفصم عنه الوحي حتى يثبت التنزيل المبارك مستقرًّا في صدره ، فيصدر عنه سهلاً سلساً ، بلسان عربيٍّ مبين ، أجمل ما نطق به إنسان قطُّ ، فتقشعرُّ منه الجلود ، وتنشرح به الصدور ، وتحيا به النفوس ، فما أن تلامس آية منه مسمع إنسان ، مقبل أو مدبر ، مستجيب أو معرض ، عربي أو عجمي : إلا وتُحدث في كيانه حدَثاً ما ، يقلُّ أو يكثر ، ينقص أو يزيد ، بحسب قوَّة إدراكه ، وسلامة استقباله ، فلا يغيب عن هذه التجربة البشريَّة إلا ساقط الأهليَّة العقليَّة ، ولولا أن الله تعالى حال بين الجبال وإدراك القرآن ؛ لتصدَّعت عروقها من عظيم وقعه ، ولتساقطت صخورها من جلال وصفه .
إن وقع آيات القرآن على نفوس البشر ، سواء من آمن به أو من جحده : أمر واقع ثابت ، لا يمكن إنكار مظاهره ، سواء ما سجَّلته التواريخ والسير من وقائع ماضية ، أو ما لمسه الناس وأحسُّوه في أنفسهم ومعاصريهم من عظيم أثره ، فما زال القرآن – وبصورة دائمة – يحرِّك القلوب ، ويثير المشاعر ، ويثري العقول ، ويبني الإنسان ، ولن يأتي عليه وقت تنضب فيه موارده ، أو تقلُّ فيه عطاياه ، فما زال القرآن كما كان دائماً ، ثريًّا بكلِّ ما يفتقر إليه البشر ويحتاجون إليه ؛ ابتداء من الاستمتاع اللغوي المثير ، الذي يشترك فيه كلُّ متدبِّر للقرآن ، وانتهاء بالهداية التامَّة ، وبلوغ منزلة الولاية الكاملة ، لكلِّ من اعتصم به بحقٍّ ، ومروراً بما يحقِّقه في أهله العاملين به ؛ من نضج العقول ، وتسديد الفهوم ، واستقرار النفوس ، وسلامة المجتمع ، وعمارة الدنيا ، وطيب العيش ، فهو بحقٍّ جنَّة الحياة الدنيا ، وتحفة الأمة الإسلامية ، وكنزها الأعظم والأجل .
ولا يجوز أن يتطرَّق إلى نفس المؤمن شكٌّ أو ريب - ولو كان يسيراً - في صدق أداء القرآن في أهله ، وعظيم قدرته في صناعة الشخصية الإنسانية المتكاملة ، وجليل أدائه في بناء المجتمع المثالي ؛ فمحمد صلى الله عليه وسلم هو بشخصه الكامل ، ومقامه الرفيع العالي ، وسلوكه الخلقي العظيم ، هو نتاج أثر القرآن ؛ فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن مقامات طويلة وجليلة ، وأوقات فريدة وعجيبة ، صاغت الشخصية النبوية في أعلى منازلها ، وأبهى درجاتها ، فليس أحد يمكنه أن يدرك من آيات القرآن ما أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يفهم منه أجلَّ مما فهمه عليه الصلاة والسلام ، بل ولا ينفعل به ، ولا يتأثر منه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد باشره جبريل - عليه السلام - بالتنْزيل العظيم ، فلم تكن هذه المباشرة الجليلة عابرة بلا مشاعر ، ولا سطحيَّة بلا مظاهر ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من تنزُّل الوحي شدَّة وثِقَلاً ، فتعرق جبهته الزاهرة وتقْطر ، ويثقل بدنه الشريف ويجْهد ، فيشعر بذلك الثقل من يباشر جسده الشريف عند نزول الوحي ، حتى الناقة الكبيرة المكْتملة النمو : تبرك لشدَّة ما تجده على ظهرها من الأحمال في لحظات التنزُّل القرآني , فكيف بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وصدق الله تعالى إذ يقول : ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ) (73/5) .
ولو أُذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التعبير عمَّا يقع في روعه من فتوح القرآن ، وعوالم الفهم ، وجديد النظر ، ولطيف الوعي : لعجزت مفردات اللغة الثريَّة أن تعبِّر عنه بكماله وجلاله على وجه الحقيقة ، فهي مقامات عظيمة من الإدراك والوعي والفتح ، ليست لأحد سوى الخليل الأعظم ، والسيِّد الأكرم عليه الصلاة والسلام ، فلم يصلنا عنه من وصف هذه المقامات النبويَّة الخاصَّة ، إلا إشراقاتها على طلعته البهيَّة ، وأنوارها على صفحته النديَّة ، وعظيم وقعها على نفسه الزكيَّة ، وحجم ثقلها على جسده الشريف .
ومع كلِّ هذا الجلال والكمال والبهاء والقوَّة ، لم يكن يزيد - صلى الله عليه وسلم – عند تعامله مع القرآن : عن تتابع ذرف العيون ، وسرعة نبض القلب ، وأزيز جوف الصدر ، حتى يجد ذلك ويشعر به من يجاوره من أصحابه – رضي الله عنهم – فما يزيدون بذلك إلا عجباً من أحواله الغريبة ، فمن رام منهم أن يجاريه في بعض مقاماته الخاصَّة ، كان عليه الصلاة والسلام يردُّه إلى ما يناسبه من أحوال المكلَّفين ، فقد قال لمن أراد منهم أن يقتدي به في وصال الصيام إلى ثلاثة أيام : ( إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) ، فهو ليس كهيئتهم ، وكذلك الحال مع القرآن ، فمقامه – صلى الله عليه وسلم – مع القرآن ليس كمقامات من دونه من أمته ، ولْيتأمَّل العاقل في ذلك هذه الأحرف المقطَّعة ، التي افتُتحت بها بعض سور القرآن الكريم ، كيف بقيت سرًّا مكْنوناً ، بين الربِّ الكريم سبحانه ، وعبده الخليل صلى الله عليه وسلم ، حتى مضى إلى ربه بخبرها ، فلم يبْلغ حقيقتها - مِنْ بعده - المتدبِّرون ؛ لأن ذلك فوق ما يُطيقون ، وهو – في الوقت نفسه - مما لا يحتاجون إليه لإقامة دينهم ودنياهم ، وإلا كان بلَّغ به الناس ، وإنما يكفيهم - تجاه هذه الأحرف المقطَّعة - الإيمان بها وترْتيلها ، فلا يطلبون فوق ذلك ممَّا لا يصلح لهم .
ولهذا أبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطر مشاهداته ، وشدَّة وقع بعض علومه على النفوس ، فلو قُدِّر لغيره أن يعاين شيئاً من ذلك ، أو أن يبلغ بعضاً مما بلغ ، لما انتفع المُعاين بتلك المقامات ، ولتعطَّلت لذلك حياته ، فلو بقيَ ليعيش ، لم تعمر به الأرض ، ولم يستمرَّ به النسل ، ولم تهنأ به الحياة ، وإنما هو الذهول والشرود والغيبوبة والتيه ، عن الطبيعة التكليفيَّة ، التي أناط الله تعالى بها الإنسان ، فوقوف العاقل عند حدِّه أفضل له وأسلم ، ولهذا اكتفى رسول الله صلى الله عليه والسلام بقوله لهم : ( لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً ، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ) ، فهذا كافٍّ لإبقاء المكلَّفين في حدود طاقاتهم الطبيعيَّة ، ضمن قدراتهم الفطريَّة ، فلا يطلبون مقاماً قد يكون فيه عطبُهم ، ولا يرجون منزلة قد يكون فيها تلفهم .
إن النفس العظيمة ، التي تحمَّلت شدَّة التنْزيل وثِقَله ، وأطاقت فواتح القرآن وعوالمه ، ثم استوت بعد كلِّ هذا في نمط بشريٍّ طبيعي ، وسلوك إنسانيٍّ سويٍّ ، ونهج اجتماعي ثري : لهي نفس فريدة مفْردة ، لا مثيل لها ، ولا شبيه بها ، ولا يمكن أن تتكرَّر في واقع الحياة البشريَّة ، فهي صنعة ربانيَّة واحدة ، قد بلغت وحدها كمالها الواحد ، الذي لا ينبغي لغيرها من الناس ، ولهذا لما فُتح على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – شيء فريد من معاني آية من القرآن ، فاستحضر طيْفاً من روعة التنْزيل المبارك ، وعاين لحظة من عظمة المشاهدة الروحيَّة : لم تُطقْ نفسه وقع ذلك الفيض الروحي ، فخرَّ مغشيًّا عليه ، ومرض حتى عاده الناس ، رغم عظيم مقامه في الإسلام ، وعلوِّ شأنه في الدين ، ورباطة جأشه في الحقِّ ، ومع ذلك كان الوارد على عقله ونفسه وروحه أكبر من أن تتحمَّله طبيعة ذاته البشريَّة ، التي لم تتهيَّأ لمثل هذا .
وهذا درس لمن دونه من الأولياء الصالحين ، والعبَّاد القانتين ، والمفكِّرين المتأمِّلين ، فلا يرومون ما لا يقدرون ، ولا يطلبون ما لا يستطيعون ، ولا يرجون ما هم عن إطاقته - إن حضر - عاجزون ، ولهذا تساقط في الطريق إلى الله تعالى - وهم على موائد القرآن الكريم - كثير من طوائف المتزهِّدين ، وجمع من المتصوِّفة المتنسِّكين ، حين تكلَّفوا خوض بحار القرآن ، بعقول متواضعة ، ونفوس رقيقة ، وأبدان ضعيفة ، فلم تُطِقْ ما ورد عليها من بعض معاني القرآن وحقائقه ، فحُبسوا في لجَّته العميقة ، لا يتقدَّمون ولا يرجعون ، وتاهوا في دروبه العريضة ، لا يهتدون ولا يبلغون ، فهلك من هلك بجُرأته ، ونجا من نجا بفضل ربه ورحمته ؛ فقد سجَّلت كتب الأعلام والسير جموعاً من : المشْدوهين الذاهلين ، والمصروعين الهالكين ، والمشْروقين المنْقطعين ، وآخرين من الغلاة المارقين ، وطوائف من البسطاء المعْتوهين ، فكلٌّ قد تكلَّف فوق طاقته ، ورام أكثر من قدرته ، حتى بلغ ببعضهم – ممن لا يُطعن في دينهم – أن يُعبِّروا عما يرد على عقولهم من الصور الذهنيَّة ، ويتحدَّثوا عمَّا يطيف بنفوسهم من الموارد الروحيَّة ، حتى تفوَّه بعضهم بما يشينهم في عقولهم ، ويشكِّك الناس في دينهم ، من أقوال ساقطة ، وعبارات باطلة ، لا يجرؤ على مثلها إلا معتوه ، قد غُلب على عقله ، أو زنديقٌ باطنيٌّ حاقد ، يقصد إلى تخريب الدين .
ولا يغيب عن وعي المطَّلع المنْصف ، طوائف كثيرة من أهل الحقِّ ، خاضوا بعضاً من بحار القرآن ولُجَجَه ، بمجاديف البصر والبصيرة ، وضوابط العقل والشريعة ، فاستخرجوا من كنوزه علوماً جليلة ، واستنبطوا من مدَّخراته نكتاً بليغة ، فنفعوا وانتفعوا ، وفادوا وأفادوا ، فأقاموا شرائع الدين ؛ بما يضبط العقائد والعبادات ، وأقاموا مصالح الدنيا ، بما يضبط العلاقات والمعاملات ، فصلح بذلك الدين والدنيا معاً ، فلا تخلو شِرْعة ربَّانيَّة من لطيفة مُستنبطة ، أو حكمة مُستخرجة ، أو نكتة مُلْهمة ، فينتفع السالك بكلِّ هذا ، فلا تجفُّ روحه وتتحجَّر بمسائل الفقه ومذاهبه الجامدة ، ولا تلين وتتميَّع بلطائف القوم ونُكاتِهم ، وإنما هو خليط مركَّب محْكم ؛ من فقه سليم ، واعتقاد صحيح ، ونسك قويم ، ولطيفة صادقة ، فمن مجموع هذا كلِّه بلغ السلف ما بلغوا من الصلاح والإصلاح ، فلم يكونوا متحجِّرين على أبواب الفقه وأصوله ، منْغلقين على مسائله وفروعه ، ولم يكونوا – في الجانب الآخر – غارقين في النكت واللَّطائف ، منْشغلين بالزهد والرقائق ، وإنما كان الاعتدال نهجهم ، والوسط سبيلهم .
ولهذا فإن قدراً يسيراً من الفتح القرآني على العبد الموفَّق ، يُقيمه باعتدال بين الترهيب والترغيب ، ويضبطه بين الخوف والرجاء ، فيستقيم بذلك على الطريق ؛ فيقيم الفروض والواجبات ، ويجتنَّب الكبائر والمحرَّمات ، فهذا خير له من درب طويل لا يبلغ منتهاه ، أو مسلك وعْر لا يُدرك عقْباه .
ولا يتعارض هذا الفهم مع كون القرآن ميسَّراً سهل التناول ، يأخذه الطفل والعجوز والأعْجمي ، فلا يثقل على أحد منهم ، حتى الأميَّ الذي لا يمكنه القراءة في الكتب والمدوَّنات – ومع ذلك - لا يعجز عن أخذ بعض سور القرآن ، فهو ميسَّرٌ للذكر والاتعاظ والاهتداء للعموم ، أما من رجا فوق ذلك من مقامات القرآن الرفيعة ، وعلومه الشريفة ، ونكته اللَّطيفة ، فهذا لا بدَّ له من شروط وأدوات لازمة ، وعلوم ومهارات مُتْقنة ، وجهود ومجاهدات متواصلة ، وهذا قطْعاً ليس لكِّل أحد ، وإلا لتساوى الجاهل والعالم في مقام واحد ، وما عاد لسؤال أهل الذكر معنى ؛ إذ الكلُّ أمام القرآن سواء ، ومثل هذا يُنكره كلُّ من له عقل يميِّز به ، أو حسٌّ يستشعر به .
غير أن غالب الناس – للأسف - ليسوا من هذه الطريقة ولا من تلك ، فلا هم سلكوا مسلك العلماء الفقهاء ، ولا هم نهجوا طريق العبَّاد الزهَّاد ، فغلب على أكثر الناس قصورهم عن القيام بواجب القرآن في العلم والعمل ، وشروطه في الفهم والنظر ، حتى قامت بينهم وبينه حُجُبٌ عِراض مانعة ، وأستار سوداء قاتمة ، فلا ينْتفعون منه إلا بالقليل ، فما زال بعضهم محْجوباً عن القرآن وهو يقْرؤه ، ممنوعاً من فهمه وتدبُّره وهو يعالجه ، وهذه أنواع من العقوبات ، التي قد تلْحق بعض المسلمين لمظالم يعملونها ، أو لذنوب يواقعونها ؛ إذ لا بدَّ من التجانس بين طهارة القرآن ، وطهارة موضع نزوله من القلب ، وإلا مضى عبر النفس ، فلا يستقرُّ فيها من فُهومه شيء .
بل ربما كان القرآن - الذي أُنزل أصلاً لحياة القلوب ، وصلاح النفوس ، وسلامة العقول - وبالاً على أُناسٍ ، وشقاءً على آخرين ، كما قال الله تعالى : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا ) (17/82) ، وقال أيضاً : ( وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ) (9/124-125) ، وهذا من أعجب العجب في شأن القرآن ، حين يكون سبب الحياة هو نفسه سبب الموت ، ومورد الخير هو عينه مورد الشر ، ومصدر السعادة هو كذلك مصدر الشقاوة ، ولهذا فإنه بقدر اليقين بالقرآن ، وخلوص مقاصد التعامل معه ، وسلامة موقع نزوله من النفس : يكون حجم الانتفاع به .
وليس هذا أيضاً على إطلاقه ؛ فقد يتناول القرآن بالفحص والتدبُّر وليٌّ من الأولياء الصالحين ، ومع ذلك لا يُفتح عليه بكثير فهْم ولا بقليله ، إذا لم يكن المولى عزَّ وجلَّ قد أذن له في ذلك ، فقد عكف على القرآن جماهير من الصالحين ، ومع ذلك لم يبلغوا من جليل فهمه مقاصدَهم ، فليس كل من أراد أمراً بلغه ، حتى وإن بذل فيه ما بذل ، وفي هذا المعنى قال ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل (7/427) : ( القرآن موردٌ يرِدُه الخلْق كلُّهم ، وكلٌّ ينال منه على مقدار ما قسم الله له ) ، غير أن ثواب اجتهاده مع القرآن لن يفوته ، وأجر تلاوته لن يعدمه ، ما دام مخْلصاً في ذلك لله تعالى ، فهو – وإن فاته من القرآن الكثير – فلن يحرمه الله تعالى - بفضله – من القرآن القليل .