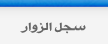الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ النَّار العظيمة
مقال شهر ذي الحجة 1436هـ
النَّار العظيمة
الحمد لله اللطيف الرحيم ، ذي القوَّة المتين ، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ، نبيِّنا وشفيعنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .. فإن حديث الناس عن الشر وأشرِّ الشر ، وعن السوء وأسوأ السوء ، وعن الألم وأشدِّ الألم ، وعن القبح وأقبح القبح ، وتعبيراتهم المتنوِّعة عن هذه المكروهات والمبغوضات : كلُّ ذلك يتضاءل ويتصاغر ، بل ربما يضمحلُّ ويتلاشى أمام ذكر النار وآلامها وفتكها وتنكيلها ، وما تخلِّفه على المبتلى بها من ألم الاحتراق ، وما تلحقه به من تشوُّه الخِلْقة والهيئة .
ولقد اعتاد الناس المفاضلة بين الأشياء ، على قدر ما فيها من الخير والشر فيتنازعون في ذلك ، أما حين يتحدَّثون عن النار فلا نزاع حينئذٍ ، إذ النار في حسِّهم جميعاً هي الشر والشر كلُّه ، فلو قدِّر لشخص مضطَّر أن يختار نوع عذابه ، لاختار أيَّ نوع من العذاب إلا النار ؛ لأن الفطرة الطبيعية في الإنسان والحيوان تنْفر منها ، وتخافها خوفاً شديداً ؛ ولهذا جاء التشريع الإسلامي بالنهي عن التعذيب بالنار ، ليكون التعذيب بها خاصًّا بالله تعالى وحده ؛ ولهذا انفرد المنتقم الجبار وحده – جلَّ وعلا – بحقِّ التعذيب بالنار ، فلا يعذب عذابه أحد .
ولا يُتصوَّر من طاغية من طغاة البشر أنه يعذب خصومه بالنار كعذاب الله تعالى ، يريد من ذلك التشبُّه به سبحانه ، ليوهم الرعيَّة بقوَّته وسلطانه وشدَّة بطشه ؛ فإن عذاب الله لا يشبهه عذاب ، ولا يساميه عقاب ، فكلُّ عذاب مهما بلغ من شدَّته ، وكلُّ عقاب مهما وصل من قسوته ، فإنه يهون إذا كانت عاقبته الموت ، فكيف بعذاب لا يعقبه موت ؟ وهذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده .
ولهذا فإن الموت الذي يختم حياة الأحياء هو أغيظ ما يغيظ الفراعنة المتجبِّرين ، حين يعذبون خصومهم ، فيكون الموت تحفة المضطهد ، ومنتهى أمله ورجائه ، فما أذلَّ الفرعون حين يموت عدوُّه بين يديه ، دون أن يبلغ من عذابه ما يرضي نفسه ، فيشفي غليل صدره ، ويطفئ نار قلبه .
إن الرجل يُضرب الضربة العنيفة التي لا يطيق وقع ألمها على بدنه فيغشى عليه ، فتكون الغشْية رحمة له وتخفيفاً ، وربما أتاه ما يكره من الأخبار المزعجة القاسية ، فيغمى عليه من شدَّة وقعها على نفسه ، فيكون ذلك خيراً له ولطفاً به ، فأية طامَّة تنزل بالإنسان حين يجتمع عليه حرُّ العذاب الأليم ، وضيق النفس الشديد ، مع دوام اليقظة والانتباه ؟ ثم يدوم عليه هذا أبد الآبدين ، في دهور متتالية لا تنقطع ، وأزمنة متعاقبة لا تنتهي ، في خلْد دائم لا منتهى له ، ولهذا فإن الخلد في نار الجحيم هو أشدُّ ما يعانيه الكافر : ( ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ) (10/52) .
إن هذه الثلاثة : ألم البدن ، وضيق النفس ، ودوام البقاء ، إذا اجتمعت على إنسان فقد بلغ المنتهى في الهلاك ، والغاية في العذاب ، فكيف إذا كان عذابه يتجدَّد ويزيد ، وزبانيته لا يملُّون من التعذيب والتنكيل ، ولا يُقلعون عن التقريع والتسفيه ؟ بل كيف يكون العذاب إذا كان بأمر وتقدير الملك الجبار ، حين ينتقم من أعدائه ، فيبطش بهم بعذاب ليس كعذاب أحد ؟ إنه حينئذٍ عذاب تعجز لغة البشر عن وصفه ، فضلاً أن يصل بشر إلى استيعاب حقيقته وكنهه .
إن نار الدنيا بكلِّ فتكها جزء يسير جداً من قوَّة نار جهنم وحرِّها وشدَّتها ؛ فهي نار سوداء مظلمة ، قد بلغت المنتهى في الحرارة والحرق ، ووصلت النهاية في الفتك والإهلاك والتدمير ، لا يخبو لهبها ، ولا يقلُّ ألمها ، فهي تُسعَّر كلَّ حين ، فيتجدَّد حرُّها ، ويزكو لهبها ، ويتنوَّع عذابها ، وما تزال كذلك على مرِّ الأزمنة والعصور المتلاحقة ، في خلد لا منتهى له ، ولا غاية يصير إليها ، فلو أن عذابها ينتهي بعد مرور سنوات بعدد رمل الدنيا : لكان لأهلها أمل يركنون إليه ويسعدون به ، غير أن قضاء الله في الكافرين أنهم خالدون فيها أبداً .
وقد وردت العديد من الأخبار في القرآن والسنة عن عجائب خلْق النار وعظمتها ، فهي مخلوق جبار شديد ، تعرف أصحابها وتميِّزهم ، وتغتاظ لرؤيتهم وتثور إليهم ، فلا تشبع من أعدادهم مهما كثروا ، ولا تملُّ من تواردهم مهما عظموا ، فدركاتها كثيرة ، وأوديتها عديدة ، وحفرها عميقة ، لا يفلت منها إلا الموحِّدون الصالحون ، ثم يتكردس فيها الكافرون والمنافقون ، قد قُرن كلُّ واحد منهم بشيطانه في تنُّور ضيِّق يُعذب برؤيته ، وتضيق نفسه بصحبته ، وآخرون يهوون أعواماً مديدة في دركات سحيقة لا يبلغون أسفلها ، وطوائف من أعداء الله مغلق عليهم في توابيت من نار بعضها داخل بعض ، مبطَّنة بمسامير من حديد ملْتهب تخزق أجسادهم ، فلا تترك موضعاً منها إلا بلغته بحرِّها ، لا يَسمعون فيها ولا يُسمعون ، وأهونهم عذاباً من يقوم على جمرتين من نار في أخمص قدميه ، يغلي منهما دماغه ، لا يرى أن أحداً أشدُّ منه عذاباً .
أما زبانية جهنم ، فغلاظ شداد ، قساة أقوياء ، لا يعرفون الرحمة ولا العطف ، ولا اللين ولا اللطف ، قد خُلقوا لذلك ، يعذب الله بهم أعداءه ، فيسلِّطهم عليهم ، فما أن يأمرهم بأخذ كافر حتى يبادروه ببطشهم ، وينتزعوه بعنفهم ، فلا يبالون بأخذه من رأسه أو قدميه ، فما يمهلونه حتى يغلُّوه بالسلاسل والأصفاد ، والحديد والأنكال ، ثم يشرعوا في تعذيبه بصنوف العذاب ؛ فالسحب على الوجوه ، والقذف والجذب في النيران ، والضرب بالمرازِب والمقامع ، فأي بدن تراه يطيق مثل هذا ؟ ولولا أن الله كتب عليهم ألا يموتوا : لماتوا من هول المطلع وشدَّته ، قبل أن يذوقوا العذاب ويعاينوا ألمه وكربته : (...وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ...) (14/17) .
إن ما وُصف من حرِّ نار جهنَّم شيء مهول ، لا يدركه العقل البشري ولا يتخيَّله ، ولا تستطيع حسابه مقاييس العلوم المتاحة ، فنجم الشمس بكلِّ حرارته الهائلة التي يحكيها الفلكيُّون : يكوَّر في جهنم ، فيصبح جزءاً منها ، وما زالت جهنَّم تُسعَّر وتُشحذ منذ خلقها الله تعالى ، فأية درجة حرارة قد بلغتها ؟ فالعجب كلُّ العجب في أجساد تصلى هذه النيران الحامية ، فتمكث فيها أحقاباً من الزمان ، ثم لا تموت ولا تفنى !
وقد وردت الأخبار بوصف طبيعة خلْق أهل النار ؛ فأبدانهم فاحشة متضخِّمة كبيرة ، وجلودهم سميكة قاسية غليظة ، حتى إن ضرس الكافر بحجم الجبل ، وموضع مقعده في النار بالأميال ، ولهذا تصمد أبدانهم لحرِّ النار بعض الوقت ، حتى إذا نضجت جلودهم وتفحَّمت : أبدلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا تجدُّد العذاب ، أما أرواحهم المعذبة فقد استقرَّت في أبدانهم ، لا تنفكُّ عنها أبداً ، مهما نالها من صنوف العذاب ، فلا هدوء ، ولا نوم ، ولا موت : (... لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ...) (35/36) .
ولهذا فإن أوَّل أماني أهل النار بعد معاينتهم العذاب هو البحث عن مخرج منها : (...فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ) (40/11) ، فإذا يئسوا من ذلك كانت الرغبة في الموت للخلاص مما هم فيه : (... يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ...) (43/77) ، فإذا أيقنوا بالخلود كان دعاؤهم ورجاؤهم الأمل في التخفيف ، ولو ليوم واحد : (... ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ) (40/49) ، وكلُّ ذلك أماني فارغة جوفاء ، ودعوات خائبة ضالة : (...فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ) (40/50) .
وإن من أعجب أماني أهل النار ، حين ييأسون من أمل الخروج أو الموت أو التخفيف : رغبتهم الأكيدة في الانتقام من ساداتهم وكبرائهم ، ممن كانوا سبب ضلالهم في الدنيا ، فيتوجَّه حنقهم وسخطهم عليهم ، بأن ينالهم مزيداً من العذب ، فيدعون الله تعالى : ( رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ) (33/68) ، والعدل الإلهي يقتضي أن ينال كلٌّ جزاءه بقدر حجم إجرامه : (...لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ) (7/38) ، ومع ذلك يتبرَّأ الكبراء من أتباعهم ، فيقوم التلاعن والتشاتم بينهم في موقف حقٍّ : ( إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ) (38/64) ، ثم تنتهي أماني أهل النار إلى ربِّ العالمين بأن يجعل رؤوس الضلال أسفل سافلين : (... رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ) (41/29) ، ولو ملك أهل النار أن يتناولوا خصومهم بأيديهم لفعلوا ، ولكن الله تعالى بحكمته حجز بينهم ، ليكون التعذيب يوم القيامة شأن الله تعالى وحده .
وأما طعام أهل النار وشرابهم - حين يشتدُّ عليهم الجوع والعطش - فصنوف من : الزقوم ، والغسَّاق ، والصديد ، والضريع ، والماء المغلي ، فليس منها ما يسمن البدن في عافية ، أو يشبع البطن في كفاية ، أو يروي الظمأ في راحة ، وإنما هي صنوف متجدِّدة من العذاب والتنكيل المهلك ، حتى إن لهم ثياباً يلبسونها ، وأساور يتحلَّقونها ، وسُرراً يفترشونها ، وأغطية يلْتحفونها ، وكلُّها من نار وقطْران ، لا تزيدهم إلا عذاباً فوق عذابهم ، وهمًّا على همِّهم ، فبئست الدار دارهم ، وبئس المقام مقامهم .
وإن من أشدِّ ما وصف الله تعالى في كتابه من عذاب أهل النار : أنهم يواجهون لهب النار بصفحة وجوههم ، فلا يملكون الانصراف عنها بتحويل أجسادهم ، أو تغطية وجوههم بالأيدي أو الأرجل ، فإن من عادة الإنسان في الدنيا أنه يحمي وجهه من الأذى بأطرافه ، أما وقد أوثقت أطرافه ، وقُيٍّدت حركاته ، فليس له إلا أن يدفع النار عن وجهه بوجهه : (...حِينَ لا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ...) (21/39) ، ( أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) (39/24) ، فلا مجال حينئذٍ للتفاهم ، أو الإمهال للنظر أو التأمل ، فالنار لا ينقطع تدفُّقها عن الوجوه والظهور .
إنه مشهد بائس شديد ، يطال الكافر في أشرف وأعز ما يملك ، فيطول به هذا المقام البائس أحقاباً طويلة من الزمان ، ولا سبيل لكفِّ النار المتوهِّجة ، ولا طاقة لرد اللهب المتتابع ، كأنه بركان يقذف حممه ، أو تنور يبعث لهبه : ( تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ) (23/104) ، فما تلبث الوجوه التي كانت في الدنيا جميلة حسنة ، والأبدان التي كانت لطيفة ناعمة : أن تحولَ كالحة سوداء متفحِّمة ، كأنها قطع من ظُلَم الليل الدامس ، قد سقطت شفاههم وتقلَّصت ، وبدت أسنانهم وتشوَّهت ، في مناظر قد بلغت المنتهى في القبح والشناعة ، مما لا يعرفها البشر ، ولم يخْبروا قطُّ بمثلها .
والعجيب أن أكثر أهل النار من النساء ، فأية طاقة للجنس الناعم بهذا البطش الشديد ؟ وماذا تصنع النار بأجسادهن الرشيقة ، وعيونهن الجميلة ، وشعورهن الطويلة ، وزينتهن العريضة ؟ قد ذهب كلُّ ذلك ؛ فالأجساد تشوَّهت ، والعيون تخرَّقت ، والشعور احترقت ، والعورات انكشفت ، والسوءات ظهرت ، ولا معين ولا مغيث ولا نصير ، قد تخلَّى عنهم كلُّ شيء ، بما في ذلك الآلهة التي كانوا يدعونها من دون الله تعالى فلا تجيبهم ، حتى أهل الجنة لا يغيثونهم بشيء ؛ فقد حرَّم الله عليهم كلَّ النعم .
حتى إذا خلص عصاة أهل التوحيد من النار ، بشفاعة الشافعين ، ورحمة ربِّ العالمين ، فلا يبقى فيها من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان : حُبس عند ذلك الكفار في النار ، فلا مجال حينئذٍ للشفاعة ولا الوساطة : (فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) (74/48) ، ولا مكان للاعتذار ولا المراجعة ولا الندم ، فالنداء لا يُسمع ، والسؤال لا يُجاب ، والصراخ لا ينفع ، فلا مالك يجيبهم بما يُريحهم : (...إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ) (43/77) ، ولا الربُّ يغيثهم بما ينفعهم : (...اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ) (23/108) ، مع ما يعانونه من شدَّة احتجاب الربِّ الكريم عنهم ، فلا ينظر إليهم سبحانه ، ولا يرونه جلَّ في علاه ، فليس لهم بعد ذلك - في شرِّ دار - إلا العُواء ، وقد أظلَّهم اليأس الذي لا أمل معه ، وخيَّم عليهم القنوط الذي لا رجاء وراءه ، لاسيما حين يعاينون بأعينهم ذبح الموت ، فلا سبيل حينئذ لأمل الخلاص ، وإنما هو الصبر الذي لا ينفع : (...فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (52/16) .
والعجيب في شأن أهل النار أنهم لا ينفكُّون عن الشرك ، ومعتقدات الكفر والضلال ، التي أوجبت لهم الخلود في النار ، وهذا ما يبرِّر دوام بقائهم فيها ، فلو قدِّر رجوعهم إلى الدنيا وقد عاينوا العذاب : (...لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) (6/28) ، وهذا من أعجب ما يوصف من طبيعة سلوك الكافر ، حين لا تطهِّره عقوبة النار ، ولا تنفع في إصلاحه ، فيكون العوْد جزءاً أصيلاً في تكوين شخصيَّته ، في حين أن أهل الكبائر من المؤمنين تنفع معهم النار حين يعذبون بها ، فتطهِّرهم من ذنوبهم ، كما تطهِّر التوبة النصوح صاحبها ، فيعود ناصعاً صالحاً .
ولئن كان حال الكافر عجيباً ؛ فإن حال المنافق أعجب ، فقد خَبَر الدين ، وخالط المؤمنين ، وعرف الحق والهدى ، وربما ذاق شيئاً من حلاوة الإيمان ، ثم هو بعد ذلك ينقلب على عقبيه ، فيستبدل الكفر بالإيمان ، والضلال بالهدى ، ومع ذلك لا يعلن ردَّته على الملأ لتبدو صفحته واضحة كحال الكفار ، وإنما يستتر بكفره بين صفوف المؤمنين ، فيكيدهم في الخفاء بما استطاع من مكائده ، وقد يمكث فيهم عمره كلَّه لا يتفطَّنون إليه إلا في آخر أيامه ، وربما يبقى مستوراً على حاله إلى ساحة القيامة ، حين يُدعى المؤمنون للسجود فيعجز الخبيث عن ذلك ، ولهذا خصَّ العزيز الحكيم هذه الفئة الخسيسة من البشر بالدرك الأسفل من النار ، في عذاب وصفه المنتقم بالعظيم : (...وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (24/11) ، فما طبيعة هذا العذاب وأشكاله ؟ فلعلَّه مما يعجز البشر عن تخيُّله ، أو محاولة تصوُّره .
وفي ختام الموقف العظيم تُغلق أبواب جهنم على الكافرين ، في سرادقات عظيمة متينة ، وعَمد ممدَّدة غليظة ، فينضم بعضها إلى بعض ، وتنطبق على أهلها انطباقاً كاملاً لا نفاذ معه ، ويدخل أهل النار في غياهب النسيان ، في سرمديَّة لا يعلم مداها إلا الله تعالى وحده .