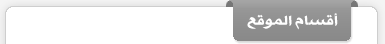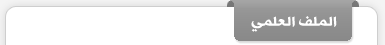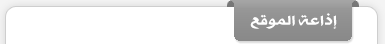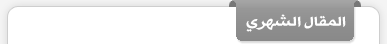
طريقة تدريس مادة السيرة النبوية الشريفة

مقال الأشهر من رجب إلى رمضان 1443هـ
طريقة تدريس مادة السيرة النبوية الشريفة
تأتي أهمية السيرة النبوية من كونها تفصيلات لأعظم شخصية بشرية عرفها التاريخ، فإنه لم يسبق ولن يحدث لرجل أن دونت تفصيلات حياته كلها، وعرفت أحواله الخفية منها والمعلنة قبل البعثة وبعدها: كما هو الحال مع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أنها التطبيق العملي الواقعي للإسلام وأحكامه، وآدابه، وتشريعاته.
وحيث إنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء بعثة، وخاتمهم، كان ولا بد أن تحفظ تفصيلات حياته، ودقائقها وجميع جوانبها حفظاً دقيقاً، بحيث لا يفلت منها شيء، فلا يكون لأحد من المعاندين، أو المغرضين مدخل يدخل منه للطعن في الرسالة المحمدية بسبب جهالة جانب من حياته عليه الصلاة والسلام، فكل حياته مدونة معروفة.







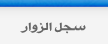

 أرشيف المقالات الشهرية
أرشيف المقالات الشهرية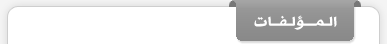

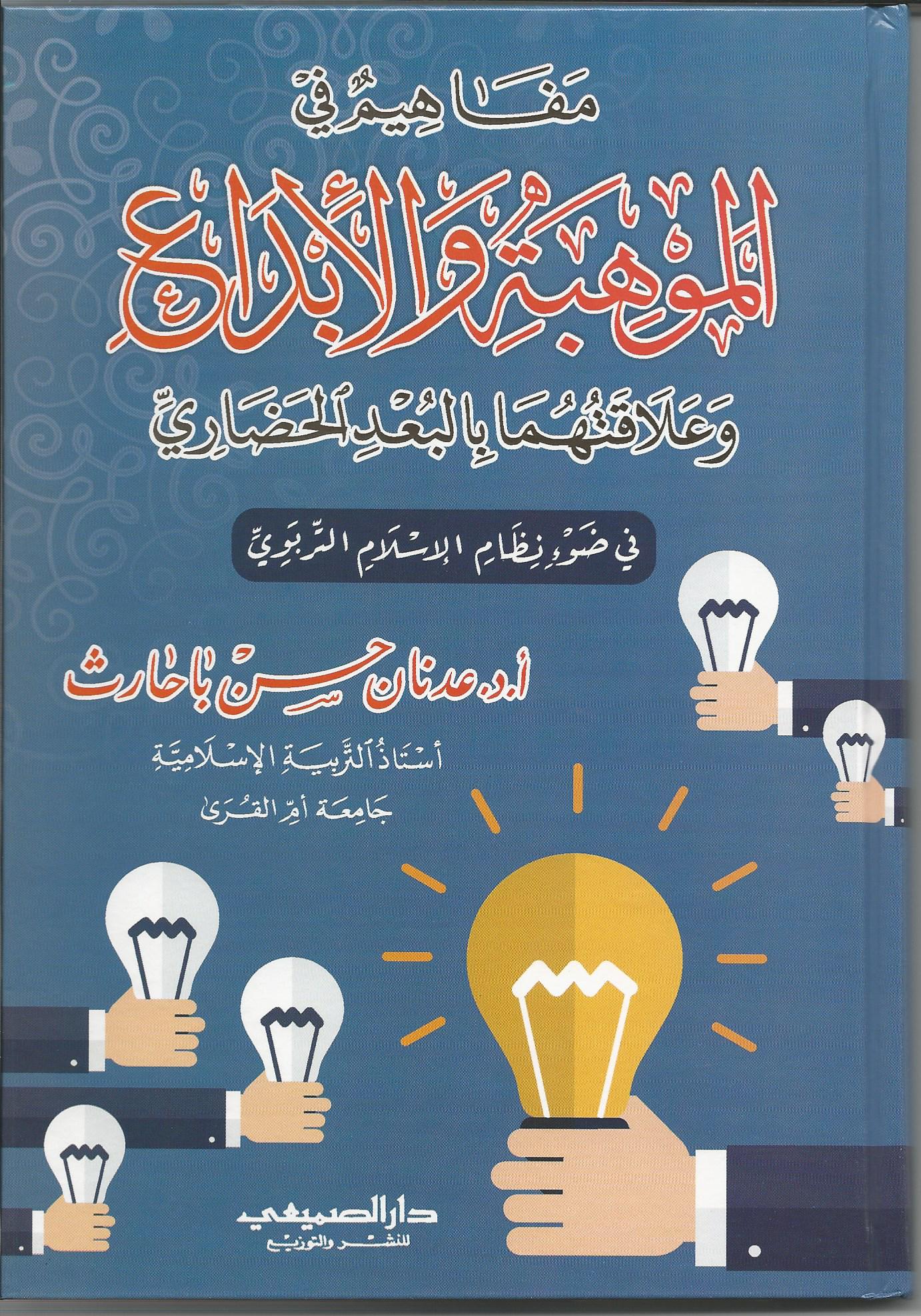
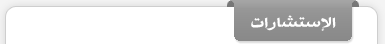

 اطلب استشارة
اطلب استشارة