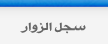الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ المتمرِّدون على الله
مقال شهر ربيع الآخر 1436هـ
المتمرِّدون على الله
الحمد لله فاطر السماوات والأرض ، جاعل الملائكة رسلاً ، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين ، وعلى خاتمهم المبعوث رحمة للعالمين ، وسيداً للخلق أجمعين ، أما بعد .. فإن للحق نوراً بيِّناً ، وسلطاناً قاهراً ، وسطوة بادية ، لا يخفى على مبصر ، ولا يغيب عن باحث ، ولا يلتبس على عاقل ، فالحق يحمل قوَّته في ذاته ، فلا يحتاج إلى مساند في إثباته ، ولا يفتقر إلى معين لإقامته ، فكلَّما كان الحقُّ آكد : كانت حقيقته أوضع للعيان ، وكانت معالمه أبين للشهود .
وإن أعظم حقيقة تجلَّت للأنام ، وأوضح حقيقة برزت للعيان : هو الله جلَّ جلاله ، وتقدَّست أسماؤه ، فكلُّ الحقائق الكونية ، وكلُّ اليقينيات القلبية ، وكلُّ الثوابت العقلية ، مهما علت وتجلَّت ، وقوي مقامها في الأذهان ، واشتدَّ سلطانها على الأفهام ، وبانت معالمها للعقلاء ؛ فإنها تأتي كلُّها بعد أحقِّ الحقائق ، وبعد أم اليقينيات ، وهو الله سبحانه وتعالى ، فكلُّ حقيقة دون ذاته العظيمة ، إنما تستمدُّ حقيقتها ، وتستفيد قوَّتها ، وتستجلب بقاءها ، منه وحده عزَّ وجلَّ ، فلا شيء يغني عن وجوده مهما عظُم ، ولا شيء يقوم بذاته مهما كبر ، فهو الأول والآخر ، وهو الظاهر والباطن ، فلا شيء قبله ، ولا شيء بعده ، ولا شيء أبين منه ، ولا شيء أقرب منه ، تقدَّست أسماؤه ، وجلَّت صفاته ، وتنزَّهت أفعاله .
إن العقل البشري يعجز عن استيعاب الحقيقة الربانية ، فهو لا يزال يتعثر في الوعي بمخلوقاته سبحانه ، بل الإنسان بكلِّ ما فتح عليه من العلوم والمعارف في القديم والحديث : يقف مشدوهاً أمام قائمة عريضة من المشاهدات والوقائع والأحداث ، التي لا يعرف لها تفسيراً ، ولا يفهم لها تعليلاً ، رغم أنه يعاينها بعينيه ، ويتناولها بيديه ، ومع ذلك يتخبَّط في تأويلها ، ويتردَّد في تفسيرها ، فأنى له أن يدرك ما غاب عن حواسِّه القاصرة ، أو أن يفهم ما فات عن زمانه المعدود ، وتوارى بعيداً عن مكانه المحدود ، ضمن ملكوت الله تعالى ، فضلاً عن أن يدرك شيئاً عن الذات الإلهية العظيمة .
إن المكان في ضيقه واتساعه ، والزمان في قصره وطوله ، والأشياء في دقَّتها وضخامتها ، والكائنات في سكونها وسرعتها ، لا تعدو جميعها ، بكلِّ ما حوته في السابق ، وتحويه في الحاضر ، وسوف تحويه في المستقبل ، من الأجرام ، والأحداث ، والحركات ، والساحات ، لا يعدو كلُّ ذلك كلمة من كلماته سبحانه وتعالى ، وإرادة من إراداته جلَّ شأنه .
وكما أن بقاء هذه المخلوقات ، واستمرارها في دأبها ، وسلامتها من فرطها : مرهون بإرادته سبحانه ؛ فإن اضطرابها وزوالها أيضاً لا يتعدَّى كلمة من كلماته ، ولا يتجاوز إرادة من إراداته .
إن المخلوق البشري المكلَّف يتوسَّط عالمين من عوالم الله تعالى ؛ عالم قد تمادى في الكبر والعظمة والشموخ ، إلى حدود لا يمكن للإنسان تخيُّلها ، فضلاً عن أن يدركها أو يستوعبها ، أو حتى يفهمها ، وعالم آخر قد تناهى في الصغر والدقَّة ، حتى حُجب بصغر حجمه عن بصر الإنسان وشعوره ، وما زال الإنسان منذ قرون يطوِّر آلاته ، ويجدِّد أدواته ، ويحسِّن أداءه ؛ على أمل أن يصل بوعيه إلى أعمق ما في هذين العالمين ، يدفعه إلى ذلك فضوله الفطري إلى المعرفة ، ونهمته الملحَّة إلى العلم ، ومع كلَّ ذلك لا يأذن الله تعالى له من العلم إلا القدر القليل ، الذي يكفي للإيمان ، ويحقِّق اليقين .
إن عوالم الغيب المحجوبة ، وعجائبه المكنونة ، وغرائبه المخبوءة ، من دقيق المخلوقات وعظيمها ، مما لم يأذن الله تعالى للإنسان في اكتشافها ، أو الوقوف على كنهها ؛ فإنه لا مصلحة للإنسان في الاطلاع عليها ، إذ لو كان ذلك مما يصلحه لأذن فيه الربُّ الرحيم ، وإلا فماذا يجني المكابر من آية خطيرة تبهته ؟ أو مشهد رهيب يفجعه : ( إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) (26/4) ، فما قيمة الإيمان الجبري ، حين تتصلَّب الأعناق ذلاً وخضوعاً لوقع تكشُّف الآية الباهرة على نفوس المستكبرين ، دون إرادة حرة منهم ، أو اختيار شخصي لهم ؟ إن الابتلاء بالإيمان حينئذٍ ينتفي ، ويقوم مقامه الإكراه والاضطرار ، فينتقل الإنسان من حال التكليف والاختيار ، إلى حال اللاتكليف والإجبار ، فلا يبقى للإنسان حينئذٍ مزيَّة يتميَّز بها عن العجماوات غير المكلَّفة .
وأمام هذه العظمة الربانية ، في حقائقها الكبرى ، ويقينيَّاتها العظمى : ينفرد الإنسان وحده بتكاليف الإيمان بها ، دون شكِّ يخالجه ، ولا تردُّد يداخله ، فيبدأ أولاً بالإيمان والإذعان والانقياد ، قبل طلب الأدلة والبراهين والمعجزات ، فإذا بادر ربَّه بالإيمان : بادره الربُّ الكريم بالهدى ؛ (...وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ...) (64/11) .
إن درجات راسخة من اليقين ، ومقامات عالية من الإيمان ، ومعالم واسعة من الهدى : يتحصَّلها المرء بالاستسلام لله تعالى ، والخلوص من الشرك ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان ، ولا إلى كثير إيضاح ، فالهدى يبعثه الله في قلب المؤمن به حال إيمانه ، حين يتكلَّم بكلمة التوحيد خالصة من قلبه ، فتنقله من دركات الكفر والضلال إلى درجات الإيمان واليقين ، فيزول بها الران ، وتذهب بها السيئات ، وينقى بها القلب ، وإنما تتأخر هذه الكلمة بصاحبها حين يقولها بغير يقين ، ويتفوَّه بها بغير تسليم ، فيبقى على باب الإيمان ، فيحتاج إلى زمن يكابد النفس وأهواءها ، ويدافع القلب وتقلُّباته ، حتى يتحفه الله بالإيمان واليقين : (قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...) (49/14) .
إن تقديم الشروط المسبقة بين يدي الإيمان : يؤخر انبعاث الهدى في القلب ، فيتعطَّل اليقين عن بلوغ درجته العالية ، فيقبع صاحبه في أوَّل الصراط المستقيم ، وعلى هامش المسير ، ينتظر الإيمان يأتيه إلى مكانه ، فيكون عرضة لقطَّاع الطريق ، يشوِّشون عليه سيره ، ويعطِّلون عليه خطوه ، حتى إذا تعثر مشيه ، وضلَّ سعيه ، وأظلم دربه : تخطَّفته الشياطين في سبل كثيرة ، وأضلَّته في دروب عديدة ، فهو حينئذٍ أسير في إحدى ثلاث مصائد ؛ فإما ردَّة ترديه ، وإما نفاق يعميه ، وإما ريبة تشقيه ، فأما المرتدُّ فسبيله الاستتابة أو السيف ، وأما المنافق فطريقه التوبة أو الاستتار ، وأما المرتاب فمصيره الإيمان أو الإلحاد .
ولقد امتدح الله المؤمنين الصادقين بقوله : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (49/15) ، لهذا فإن دفع الشكوك عن القلب ، وتبديد الأوهام عن العقل ، هو نهج المؤمنين الصادقين ، فليس من أحد يسلك درب الإيمان ، إلا وقف له الشيطان ببعض الطريق ، يصدُّه عن الحقَّ ، ويردُّه عن الهدى ، فإن دافعه وقاومه وعانده ، انعطف إلى باب الوسوسة والشكوك ، فما يزال المؤمن معه في عراك طويل ، يمتدُّ معه إلى آخر زمان العمر ، ينشط أحياناً ، ويخنس أحياناً أخرى ، فلا يكاد ينجو من قذائفه أحد ، حتى الصحابة الأولياء ، والمؤمنون الأتقياء ، يتحيَّن السِّنَة والغفلات ، ويترقَّب النسيان والسهوات ، فلا يملُّ ولا يكلُّ ، فبقدر الإيمان واليقين : تندفع أوهامه ، وتنجلي أفكاره ، وإنما تعْلق الفكرة الرديئة بقلوب السفهاء ، فيظنُّ أحدهم أنه وقع على أمر جليل لم يقع عليه أحد ، فينشط السفيه لوساوسه ، وينسج عليها من نتن أفكاره ، فتجتمع عليه الوسوسة ونتن الفكر ، فتهويان به في دركات سحيقة ، ربما انتهت بصاحبها إلى الإلحاد الصريح ، (...وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ) (22/31) .
إن من الصعوبة بمكان الغفلة عن موجة الإلحاد المعاصرة ، التي يخوضها جمع من الشباب المتمرِّدين ، في ظلِّ الانفتاح الفضائي ، الذي سمح للفرد أن يبسط نتائج عقله على الملأ بثمن زهيد ، ووقت يسير ، فتبلغ فكرته – أياً كانت – الآفاق كلَّها ، فيتواصل معه أشباهه من السفهاء ، ويدعمهم جمع من الأوغاد المغرضين ، فما تلبث الفكرة الرديئة أن تتجذر في تربة النفس الفاسدة ، فتلقي بجذورها في أعماقها ، ثم تنتج نتاجها في قائمة من الاعتراضات والاستنكارات الجريئة ، وقائمة أخرى من الاستفسارات والاستفهامات الغريبة .
إن سؤال الشبهة - مما قد يرد على النفس الضعيفة – تردُّه النظرة الصحيحة ، وتبدِّده الحجَّة القويَّة ، فما تلبث الشبهة طويلاً حتى تزول عن النفس ، مخلِّفة وراءها راحة وطمأنينة ويقيناً ، وإنما تتشبَّث الشبهة بقلب صاحبها حين يغلِّفها الهوى الغلاب ، ويسقيها الغرور المستحكم ، ويدعمها حبُّ الشهرة المفرط ، وما أدلَّ على ذلك من بلوغ المتمرِّدين باعتراضاتهم رفض الذات الربانية المقدَّسة ، باعتبار ذلك وهماً وأساطير ، لا ترقى – في نظرهم – إلى عقيدة تطمئن لها نفوسهم !! فمثل هذه الجرأة المقيتة لا تأتي من المسلم من جرَّاء شبهة محيِّرة ؛ إذ إن مخالفة الفطرة الإنسانية ، ومعاندة الضرورة العقلية ، ومكابرة الشواهد الكونية : يُحيل وقوع مثل هذه الشبه ، ويستهجن وجود قناعاتها في عقل المسلم ، وإنما هي الرغبة في الاشتهار ، ضمن موضات بعض الشباب الشاردين وتخليعاتهم ، من خلال تبنِّي أطروحة مرذولة كهذه ، يستنكرها غالب البشر ، وهي عند المسلمين أنكر المنكرات ، وأعظم الموبقات على الإطلاق .
إن الإنسان المسلم لا يقدم على مثل هذه المنكرات الفكريَّة ، إلا حين تتشوَّه نفسه تشوُّها كاملاً ، وتظلم روحه ظلمة تامَّة ، فينحطُّ بعقيدته الشاذة دون دركات الكافرين ، ضمن طوائف المنافقين ، فقد بطش الله بأقوام سبقوا في التاريخ البشري ، ما أنكروا إلا الألوهيَّة ، فأخذوا جميعاً بصنوف العذاب الأليم ، فما بقيت منهم باقية ، فماذا تُرى يُصنع بمن زاد على كفرهم كفراً ، وردَّة على ردَّة ؟! ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ) (4/137) .
إن جماهير الكفار في القديم والحديث ، عبر التاريخ الإنساني الطويل : لم يُنقل عنهم اعتراض على مبدأ توحيد الربوبية ، الذي كان ولا يزال عقيدة عامة في عموم الطوائف البشرية ، باعتباره أمراً فطرياً ، لا يحتاج إلى كثير نظر وتأمُّل ، وإنما ظلَّ الإلحاد خيطاً دقيقاً في التاريخ البشري ، ولهذا كانت عبارة الرسل لأقوامهم في مسألة الربوبية : (... أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ...) (14/10) ؛ إذ لا شكَّ مطلقاً في الاعتقاد بالله الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه ، وإنما جلُّ الصراع انحصر في قضية الألوهية ، وما يترتب على الإيمان بها من نبذ الأنداد ، وتوحيد العبادة ، وكمال الطاعة والانقياد ، ولهذا كانت كلمة الرسل جميعاً بشأنها : (...اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...) (23/23) .
إن واقع المسلمين المعاصر ، بكلِّ عيوبه ومراذله وإحباطاته ، لا يمكن أبداً أن يكون عذراً لمتمرِّد يتذرع به للجرأة على الله تعالى ، سواء كان في واقع الاستبداد السياسي وصراعاته البغيضة ، أو الأزمات الاقتصادية الخانقة ، أو المظالم الاجتماعية القاسية ، أو حالة التخلُّف الحضارية ، أو فقدان القدوة السلوكية الصالحة ، كلُّ ذلك ونحوه لا يمكن أن يكون مسوِّغاً يتذرَّع به المتمرِّد لإنكار الذات الإلهية ، وإنما هذه البلايا أنماط من الابتلاءات ، التي يختبر الله بها عباده : (...وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) (21/35) ، فالابتلاء الرباني يتنوَّع بين الخير والشر ، حسب مقتضى حكمته البالغة ، وحجَّته الدامغة ، إذ الكلُّ تحت سلطان إرادته ، فليس للعبيد حقٌّ عنده إلا ما أوجبه - سبحانه - على نفسه ، فالبشر يتقلَّبون تحت مشيئته ، بين فضله وعدله ، فلا حجَّة لأحد عنده ، كائناً من كان .
إن تأملاً يسيراً في عواقب هذا الاعتقاد الباطل في الرب سبحانه : يكشف للمتمرِّد فداحة هذه الفكرة المنكرة ؛ لأن هدم العقيدة في الرب سبحانه وتعالى هو هدم لعقيدة الألوهية ، وهذا يفضي – بالتالي - إلى تهديم نتائج هذه العقيدة في الشريعة والأخلاق والنظم الاجتماعية ، التي تفتقر – بالضرورة – إلى البعد الرأسي ، في إله عظيم حكيم ، تخضع له إرادة الإنسان خوفاً وإجلالاً ، ويستمدُّ منه المكلَّفون أحكامهم ، وما يضبط نظمهم وتشريعاتهم ، ويُحكم بينهم علاقاتهم ، ويقرِّر الحقوق والواجبات فيما بينهم ، فإذا زالت عقيدة الإله الحق من النفوس والأذهان : زالت معها كلُّ آثارها الواقعية التي ينعم بها الناس منذ الأزل ، من التشريعات والأحكام والنظم ، فأيُّ واقع خطير يمكن أن تفضي إليه فكرة إنكار الرب سبحانه وألوهيَّته ؟
إن المسلم العاقل حين يُلحد ، معتقداً استغناءه عن الربِّ سبحانه وتعالى وعن ألوهيَّته ؛ فإنه – بالضرورة - لابد أن يستغني عن تشريعاته وأحكامه ، مثل : تحريم قتل النفس المعصومة ، واستباحة الفروج المحرمة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، ونحوها من الموبقات التي اتفقت كلمة الرسل على تحريمها ، وتقبَّلت ذلك العقول السليمة ، فماذا تراه يصنع المتمرِّد بهذه الأحكام ، هل ينكرها لأنها من عند الله تعالى ، الذي لا يعتقد بوجوده ، فيبيح للمتعدِّين نفسه وعرضه وماله ؟ أم يقرُّ بمقتضاها ، وينكر منزِّلها ؟ أم تراه يستطيع أن يأتي بمثلها من عند نفسه ، ثم يسبغ عليها من ذاته قداسة ، تدفع الناس للالتزام بها ؟
إن الاعتقاد بالإله الحقِّ ضرورة حتميَّة للانضباط بالتكاليف والمسئوليات ، والالتزام بالأخلاق والآداب ؛ لأنه لا يُتصوَّر من الإنسان أن يقوم بالواجبات من تلقاء نفسه ، حتى يُؤطَر على ذلك أطراً بالترغيب والترهيب ، ضمن عقيدة صحيحة في الله تعالى ؛ لأن القانون وحده - مجرَّداً عن أثر البعد الغيبي - لا يجدي في ضبط الإنسان بالتكاليف ؛ فإن الإيمان بالغيب هو روح التشريع الإسلامي ، الذي يعتمده في إلزام الناس بالعمل به ؛ ولهذا لا يسقط الحكم الشرعي عن المكلَّف ديانة إذا غاب الرقيب ، كما يحصل في النظم الوضعية ، التي لا سلطان لها على الضمير البشري .
ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام : أني التقيت – زمن شبابي - رجلاً ملحداً ، على متن طائرة أجنبية ، فدار بيننا حديث في شأن الوجود الضروري للربِّ الخالق عزَّ وجلَّ ، حتى بلغ بنا الحديث إلى زعم الملحد أنه لا يحتاج إلى سلطان الإيمان بالغيب لضبط سلوكه الخلقي ، والتزامه بالواجبات المنوطة به ، فهو – حسب زعمه – لديه من الحصيلة الأخلاقية ما يغنيه عن سلطة الإله سبحانه ، إلى أن وصل بنا النقاش إلى مسألة تعدُّد الزوجات في الإسلام ، التي اعتبرها جريمة خلقية في حق المرأة ، ومع ذلك أقرَّ الملحد بتجاوز نسب الإناث في مجتمعه نسب الذكور ، فكان السؤال المعروض عليه في شأن الإناث الباقيات دون زواج رسمي : ماذا يصنع المجتمع بهن ؟ فهل يحرمن من النكاح والذرية مطلقاً ، أم يُستخدمن خلائل وأخداناً بعيداً عن علم الزوجات ؟ أم يتزوج الرجل بالاثنتين أو الثلاث أو الأربع منهن ، ضمن عقد شرعي ملزم بالحقوق والواجبات ، فتعطى كلُّ واحدة منهن عين حقوق الأخريات دون ميل ولا حيف ؟ فإذا بالملحد الأثيم يرجِّح الزواج الرسمي بواحدة ، ويقترح للأخريات المخادنة والمخاللة سراً عن الزوجات ! فبادرته بالسؤال : كيف تصنع إن اكتشفت زوجتك علاقاتك بالخليلات ؟ قال : أكذب وجود ذلك وأنكره ، فقلت له عندها : لقد زعمت آنفاً أن لديك من الحصيلة الأخلاقية ما يكفيك لضبط سلوكك الخلقي ، فها أنت تحتاج إلى الإيمان بالغيب لضبط سلوكك ! فانخنس الملحد البغيض متبسِّماً ، ودفع بكرسيِّه إلى الخلف ، ثم غرق في نوم عميق ، فما سمعت صوته بعد ، حتى فرَّقت بيننا نهاية الرحلة .
إن كلَّ أهواء هؤلاء المردة تتكسر متحطِّمة على صخرة القرآن وعتبة التاريخ ؛ ففي الشأن القرآني لابد لهم من الإتيان بمثله ، حتى يبطلوا مصدره الرباني ، وأنى لهم ذلك ؟ وأما التاريخ فلا بد لهم من تفسير أحداثه ووقائعه تفسيراً إلحادياً مقنعاً ، مبرِّرين ظاهرتي النبوَّة والأنبياء ، وما ترتب عليهما في تاريخ البشر من الإيمان والكفر وأحداث الحياة ، وهذا أمر بعيد المنال ، فلا يبقى لهم بعد ذلك إلا الهوى يتذرَّعون به : ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ) (45/23) .