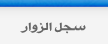الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ التربية بالشعائر التعبُّديَّة
مقال شهر رمضان 1435هـ
التربية بالشعائر التعبُّديَّة
الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، وإمام المتقين العابدين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .. فإن العبادة بمفهومها الخاص تشير إلى الشعائر التعبُّديَّة ، ممثلة في أركان الإسلام الخمسة : الشهادتين ، والصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج .
وعلى الرغم من أن هذه العبادات لا تستهلك من وقت الإنسان وعمره إلا اليسير ، ومع ذلك تؤثر في بناء معالم شخصيَّته أبلغ التأثير ، وتعمل في تكوين اتجاهاته الفكرية ، وتحديد اختياراته السلوكيَّة ؛ فالشهادتان على سهولة أدائهما ، وقصر زمن النطق بهما : تنقل الإنسان – في لحظات يسيرة - من حضيض الشرك والكفر إلى القمَّة الإيمانيَّة السامقة ، التي تؤهِّل الناطق بهما إلى رحمة الله ورضوانه ، ما دام ينطق بهما موقناً من قلبه ، إنه سرٌّ أودعه الله تعالى هذه العبارة الوجيزة ، حتى إنها من عظمتها لتزن السموات والأرض مجتمعة .
ولقد بدا واضحاً أثر الشهادتين المباشر في شخصيَّات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ في اتجاهاتهم الفكرية ، وفي طرائقهم السلوكيَّة ؛ فمن التمادي في الكفر والضلال ، إلى المسارعة في الخيرات والصالحات ، حتى إن أحدهم ما إن ينطق بهما في مجلسه الأول ، حتى يعود سيفاً من سيوف الله تعالى ، ونجماً من نجوم الهدى والاستقامة ، فإذا بالنفس الملوَّثة بأدران الشرك والجاهليَّة : تتحرَّر من أدرانها في لحظات يسيرة ، فترتقي بالتوحيد الخالص إلى أعلى المراتب ، فلو قُضي عليها في هذا الحين بالموت ، لكان صاحبها من أهل الجنة قطعاً ، في حين أنه قبل أن يتلفَّظ بهما كان من أهل النار ، فما هي إلا لحظة قصيرة ، وفارق يسير ، يفصل بين عالميْ السعادة والشقاوة ، فما هو السر الذي تحمله هذه الجملة الوجيزة ؟ وما هو الإكسير المتضمن في هذه العبارة القصيرة ؟ الذي يُحيل التعيس الشقي إلى سعيد هانئ ، والسافل المنحطَّ إلى سامق رفيع !!
إنه السر نفسه الذي رجحت به الشهادتان على السموات والأرضين ، حين تقابلهم في كفَّة الميزان ، فلا شيء – أيًّا كان - يرجح بكلمة التوحيد الخالصة ، حين ينطق بها اللسان من قلب صادق مقبل .
ولعل مفهوم التربية بالعبادة يتضح أكثر مع الركن الثاني من أركان الإسلام ، حين يتقدَّمه المؤمن بعبادة الوضوء ، التي تظهر فيها العبوديَّة أبلغ ما تكون ؛ من خلال سكب الماء الطهور على أعضاء محدَّدة من جسم المكلَّف ، بترتيب وإسباغ ، ونيَّة صحيحة سابقة ، لا مجال للاجتهاد العقلي في ذلك ، إنما هي العبوديَّة لله تعالى في طاعة المشرِّع سبحانه ، فالعبادة لا تأتي دائماً بما يُعقل ، إذ لو كانت العبادة بالعقل دائماً لكان من الأولى مسح الخفِّ من أسفله لا من أعلاه ؛ لكونه أنظف وأنقى ، ولكان التيمُّم بغير التراب أولى من تعفير الوجه به ؛ إذ الجمع بين الماء والتراب لتحقيق الطهارة لا يُعقل ؛ فالماء مُنقِّي بلا خلاف ، أما التراب فهو على العكس من ذلك ، ومع كلِّ هذا جُمعا معاً لتحقيق عبادة واحدة .
إن مراد المشرِّع الحكيم - من تغييب الرأي عن بعض هذه التشريعات - هو تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى ، التي تستلزم من المكلَّف تمام الخضوع والتذلُّل ، المتضمِّن كمال الطاعة والإذعان ، بتنفيذ الأداء التعبُّدي دون اعتراض ، فالعالم والعاميُّ ، والذكيُّ والغبي ، كلُّهم في العبادة سواء ، وإنما يتفاوتون في درجتي الإتقان والإخلاص ، بمعنى أن أعبدهم - في هذا الشأن - أكثرهم طاعة وإذعاناً وتسليماً في تنفيذ مراد الله تعالى .
وأما الجانب التربوي لعبادة الوضوء ، المتضمِّن استقامة العابد السلوكيَّة ، فيكمن فيما يخلِّفه الوضوء من أثر صحِّي على القلب ، بتنقيته من ركام الخطايا ، وتطهيره من عبء الران المتراكم عليه ؛ فما من قطرة من ماء الوضوء ، إلا وتزيل معها بقدر ذلك من شؤم المعصية وقذرها ، حتى يعود القلب طاهراً من آثارها الرديئة ، طليقاً من أحمالها الثقيلة ، وقد فُتحت له أبواب الجنان الثمانية ، فإذا أشرق القلب بآثار الوضوء على هذا النحو : ظهرت عندئذٍ أنوار الوضوء ، كما جاء في الحديث : ( الوضوء ضياء ) ، وعندها ينعكس ذلك الأثر الحسن على الجوارح استقامة وأدباً ، فلا يخطو الطاهر ولا يسلك إلا وفق ما وقر في قلبه من الخير ، فهو المضغة التي بها صلاح سائر البدن .
وفي مقابل هذا الإشراق الروحي ، والانشراح النفسي ، والاستعداد للإلهامات الحسنة : ما يخلِّفه الحدَث في النفس والمزاج من الظلمة والضيق ، والوحشة والتشويش ، حين يتمكَّن من الإنسان ويحيط به ، فإنه يورث الوساوس الشيطانية ، والمنامات الموحشة ، والواردات الرديئة ، ولهذا كانت إدامة الطهارة والوضوء من دأب الصالحين .
والشأن في عبادة الصلاة لا يختلف كثيراً عن عبادة الوضوء ؛ فالناحية التعبُّدية واضحة المعالم في أدائها ، سواء في ألفاظها وعباراتها الملزمة ، أو في حركاتها المنتظمة الرتيبة ، أو في أعداد ركعاتها المحدَّدة ، أو في أزمنة مشروعيَّتها المؤقَّتة ؛ ففي كلِّ عناصر الصلاة ومكوِّناتها تتجسَّد العبودية لله تعالى ؛ فلو رام متحذلق أن يتملَّق ربه بزيادة ركعة خامسة على صلاة الظهر ، أو إضافة فرض سادس على الفروض الخمسة ، أو حتى زيادة سجدة واحدة لصلاة من الصلوات ، فضلاً عن أن يُنقص من ذلك شيئاً ، أو يقدِّم أو يؤخِّر : لأعد المتعمِّد لذلك مبتدعاً آثماً ، مأزوراً غير مشكور .
وهكذا الرأي المجرَّد عن المسوِّغ الشرعي مرفوض في مسألة التعبُّد ؛ لأنه يسلخ العبادة من معنيْ الخضوع والتذلُّل ، الضروريين لصحَّة العبادة وسلامتها , فالله تعالى لا يُعبد إلا بما شرع : ( إياك أريد بما تريد ) .
وأما المقصد السلوكي من إقامة الصلاة فيتلخص في قول الله تعالى : (...وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ...) ؛ فالأثر التربوي على سلوك المصلِّي مقصد أصيل من مقاصد الصلاة ، لا يتصوَّر غياب أثره الإيجابي عن المكلَّف ، إلا حين يفقد شرط إقامة العبادة ، الذي يستلزم الانقياد ظاهراً وباطناً لأحكامها الشرعيَّة ، والمجاهدة الصادقة في ذلك .
وعمل الصلاة في مُقيمها كعمل الوضوء فيه ؛ فإنها تزكِّي النفس ، وتطهِّر القلب ، بإزالة رجس المعاصي والذنوب ، حتى تتهافت عن المصلِّي تهافت الورق عن الشجر ، كحال تكرار الاغتسال في الماء ، لا يُبقى من درن البدن شيئاً ، كما قال الله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ...) ، وهذا من شأنه أن ينعكس على الجوارح استقامة وسلوكاً حسناً ؛ فقد شكا أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي الليل ، فإذا أصبح سرق ، فقال : ( إنه سينهاه ما تقول ) ، وهكذا الصلاة لا تمضي عن المصلِّي حتى تخلِّف أثراً إيجابياً على سلوكه ، بقدر ما يبذل من جهد في إقامتها .
وأما عبادة الصيام فشأنها عجيب ؛ فهي إمساك عن المفطِّرات بنيَّة سابقة ، ابتداء من ظهور الفجر الصادق إلى تمام مغيب الشمس في الأفق ، إذا أنجز الصائم يومه ذاك إيماناً واحتساباً ، فإنه ينتظر أجراً عند ربه ، يعجز العقل عن تخيُّل مثله ، أو التكهُّن بقدره وكنهه ، فهو خارج نطاق الخيال البشري ، مع ما يحدثه الصيام من انشراح الصدر ، ونقاء القلب ، وصفاء الذهن ، وصحَّة البدن .
والعجب في فلسفة الصيام يكمن في نيَّة الامتناع ذاتها ، وليس في الامتناع نفسه ؛ فقد يمتنع الإنسان عن المفطِّرات ظاهراً لمقاصد متنوِّعة دون إرادة التعبُّد ، وقد يغفل عن الامتناع عن المفطِّرات مع إرادة التعبُّد ، وشتَّان بينهما ، فالأول عاصٍ ليس له من جهد الصيام إلا ما نوى ، وأما الثاني فلم ينقص من أجره شيء ، فهو لا يزال صائماً ، ما دام مريداً للصيام قاصداً له ، حتى وإن لم يمتنع بسبب عارض النسيان ، (...فإنما أطعمه الله وسقاه ) ، ففي الوقت الذي تُفسد فيه قطرة الماء وحبَّة الأرز صيام المتعمِّد ، مع عجزهما التام عن إقامة صلْبه ، وفي الوقت أيضاً الذي يفسد فيه صيام اليوم كلِّه بتقدُّم الصائم لفطره عمداً لحظة واحدة عن تحلَّة الصيام : فإن وجبة الطعام وكوز الماء في نهار رمضان لا يضرَّان صيام الناسي في شيء ، مع ما يحدثانه للصائم من تمام الشبع والامتلاء !!
إن المقصد الجليل في إرادة التعبُّد هو جوهر عبادة الصيام ولبُّها ؛ ولهذا المعنى اللطيف اختصَّ الله تعالى نفسه بثواب الصيام ، وفي الحديث القدسي : (...الصيام لي ، وأنا أجزي به ) .
وأما لطيفة الأثر التربوي للصيام على السلوك ، فتنتهي إلى مقام التقوى ، الذي يأتي أهمَّ مقاصد الصيام ، والغاية الكبرى من مشروعيته ، ولئن كان مستقر التقوى القلب ، فإن السلوك الإنساني ترجمة دقيقة لمعانيها ؛ فالامتناع عن مسالك : الرفث ، والصخب ، والسباب ، هو انعكاس سلوكيٌّ أكيد للصيام الصحيح ، وأثر واضح للأداء التعبُّدي المقبول ، فالسلوك الشخصي للصائم هو منتهى أثر عبادة الصيام ؛ بمعنى أن العبادة المتقنة ينتهي أثرها الطيب إلى السلوك الشخصي القويم ، ولعل في حديث : (...من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج...) ، ما يعطي الدلالة الأكبر على الارتباط الوثيق بين العبادة والسلوك ؛ فالزواج يعين الشاب على غض بصره وتحصين فرجه ، فإذا عجز عن مئونته ، فإنه يجد في الصيام ما يقوم مقام الزواج في حفظ النظر والفرج .
وتأتي عبادة الحج بنسكها الفريد ، وأدائها المتميِّز ، لتغسل الحاج من ذنوبه وخطاياه غسلاً لا يُبقى أثراً لذنب ، ولا يخلِّف بقيَّة لمعصية ، من خلال أداء تعبُّدي خاص ، يشترك فيه البدن بالجهد والمجاهدة ، ويُبذل فيه المال بالنفقة والعطاء .
وتتلخص عبادة الحج في أداء بدني ضروري ، يبذله الحاجُّ في زمن مخصوص ، ضمن أماكن مخصوصة ، لا بديل عنها ، فلا يقوم مقامها شيء من الأزمنة ولا الأمكنة ، إذ لا دخل للعقل ولا الرأي في ذلك ، وإنما هي تعيين بالوحي كحال سائر العبادات ، ولئن كانت الحكمة الإلهية تنتظم جميع الأحكام الشرعية ، إلا أنها كثيراً ما تخفى علل الأحكام على الناظر في شأن العبادات ؛ لأن مقصود العبادة الأكبر هو الطاعة والخضوع والتذلُّل وليس التعقُّل ، فلا يتمُّ ذلك بكماله إلا بخفاء حكمة التشريع وعلَّته عن المتعبِّد ، فيخلُص مقصده للعبادة ، ويتحرر عقله من التعلُّق بالعلل ، وتتجرَّد نفسه من حظِّها في القناعة الشخصيَّة ، التي قد تأتي أحياناً مجانبة للحكمة الربانيَّة ، ولهذا يصعب تعليل جميع المناسك التعبُّديَّة بالعقل ، وما قد يقبل منها التعليل العقلي يصعب الجزم به ، وهذا على خلاف المعتاد في الأحكام غير التعبُّديَّة ، التي غالباً ما تأتي محلاة بالعلَّة من حكمة تشريعها .
وأما الجانب السلوكي ، الذي تحدثه عبادة الحجِّ في المسلم ما أشار إليه المولى عزَّ وجلَّ بقوله : (...فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...) ، فالمسألة التربويَّة في إصلاح السلوك مقصودة من هذه العبادة ، وهي انعكاس طبيعي للحجِّ المبرور ، ولهذا لما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كنْه الحجِّ المبرور فسَّره تفسيراً سلوكيًّا فقال : (إطعام الطعام ، وطيب الكلام ) ، فالعبادة الصحيحة تعكس السلوك القويم .
وعلى الرغم من تشابه نهج العبادة بين : الوضوء ، والصلاة ، والصيام ، والحجِّ ، فإن عبادة الزكاة تستقلُّ بنهج آخر لمعنى التعبُّد ؛ إذ لا عمل محدَّداً فيها ، ولا طقوس معيَّنة لها ، وإنما تتكوَّن العبادة فيها من ثلاثة عناصر : ملك المال ، وبلوغ النصاب ، وحولان الحول ، فإذا اجتمعت هذه العناصر للمكلَّف – في غير الخارج من الأرض وزكاة الفطر- وجبت عليه عبادة الزكاة ، فيُخرجها لطائفة مخصوصة من الناس .
إذا أخرج المسلم القدر الشرعي من المال المزكَّى ، معتقداً وجوبه عليه ، طيِّبة به نفسه ، فإنه بمجرَّد تمكين المستحقِّين من حقِّهم الشرعي : يستقبل الحياة بروح جديد ، ونفس مشرقة نقيَّة ، وصدر واسع منشرح ، قد خلَّصته الزكاة من شرِّ نفسه ، وطهَّرته من شحِّ قلبه ، وحفظته من ضيق صدره ، وحصَّنت ماله من المحق ، وكانت دليلاً ساطعاً على إيمانه ، وبرهاناً أكيداً على صدقه ، وفي الحديث : ( الصدقة برهان ) ، فيكون بذلك قد أقام ركناً من أركان الإسلام ، يتأهَّل به إلى حياة أرحب ، وسلوك أفضل ، وخلق أحسن .
وفي مقابل ذلك ما يحصل من الأرجاس والأدناس لمانع الزكاة ، حين تجب عليه فيجحدها ، أو يمتنع مستكبراً عن أدائها ، فيقع بذلك في هوَّة سحيقة عميقة ، لا يعرف لها قعراً ، يتردَّى في دركاتها منحطًّا إلى أسفل سافلين ، لا يبقى له خير يُذكر ، ولا شخصيَّة تُحترم ، ولهذا استباح المسلمون - زمن أبي بكر رضي الله عنه - دماء مانعي الزكاة - على اختلاف ديارهم وفئاتهم ، وتنوِّع معتقداتهم وآرائهم - فلم يعذروا في منعها بشيء .
إن التربية بالشعائر التعبدية – على نحو ما تقدًّم - تغني عن كثير من جهود أساليب التربية الأخرى ومعاناتها ؛ كالقدوة ، والوعظ ، والتذكير ، وضرب المثال ، والقصَّة ، ونحوها إن وقعت متقنة على ما فرض وسنَّ المشرِّع سبحانه تعالى ، فهي حزمة مجتمعة من : المشاعر الصادقة ، والمقاصد الصالحة ، والتسليم الكامل ، والاعتقاد الصحيح ، والأداء السليم ، تكوِّن في مجموعها مهمة العبادة ، التي خُلق المكلَّف من أجلها ، فتعمل الشعيرة التعبُّديَّة في المكلَّف عملها الفريد ، من خلال الأسرار الإلهيَّة التي أودعها الله تعالى فيها ، والخصائص الربانية التي ادَّخرها فيها ، فتحدث فيه التغيُّرات الفكريَّة السديدة ، والاتجاهات السلوكيَّة الحميدة ، بقدر سلامة إخلاصه ، وجهاد متابعته .
إن من أولويَّات السياسات التربويَّة وخططها : العمل الجاد لتفعيل أسلوب التربية بالشعائر التعبُّديَّة في المؤسسات التربوية ، ليكون جزءاً أصيلاً من برامج التربية ومناهجها ، يُؤسس له في العمليَّة التعليمية ضمن خطط تربويَّة مدروسة وممنهجة ، تتناول الطالب – متدرِّجة به – في مدارج التعبُّد ، ومسالك التألُّه ، فتعرج به في سلَّم الكمالات خطوة بخطوة ، لتبني فيه الشخصيَّة التعبُّدية ، على نهج إسلامي قويم ، وسنة نبوية ماضية ، وخطى سلف صالح .
إن قدراً كبيراً من معاناة التربية الحديثة وشكواها المتصاعدة في المؤسسات التعليمية يمكن أن يخفَّ ، وربما يضعف فلا يشكِّل أزمة تربويَّة ، من خلال اعتماد منهج التربية بالعبادة ، الذي يصوغ الإنسان صياغة تربويَّة خاصَّة ، تؤهِّله للقيام بالتكاليف الشرعيَّة المختلفة المنوطة به ، مما عجزت عن تحقيقه مؤسسات التربية الحديثة ، وأخفقت في القيام به وفق الخطط والأهداف الموضوعة ، مما أحبط تطلُّعات المجتمع ، وأجهز على آماله .