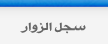الصفحة الرئيسة @ المقالات التربوية @ التربية الأخلاقية @ 10ـ خطر الرسالة الإعلامية الغربية على ثقافة الأمة الإسلامية
إن الأمة الإسلامية تعيش تحديات كبيرة، وصراعات عظيمة، ضمن ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة، لم يسبق لها أن خاضت مثلها في حِقَبِ عصورها الماضية، فرغم ما أصاب الأمة الإسلامية من الفتن والبلايا في فترات من تاريخها الماضي؛ فإنَّ ما تعانيه اليوم من التحديات والصراعات يفوق في جملته وحدَّته ما عانته في السابق، ويختلف في طبيعته وأساليبه عما كان عليه الأمر في الماضي.
ولعل أبرز ما يميز فترة الصراع الحالية، ويجلي طبيعتها استخدام أسلحة جديدة متفوقة في ساحة الصراع الإنساني لم تكن مستخدمة في السابق بالطريقة العصرية التي تستخدم بها اليوم، فرغم التفوق الحضاري والعسكري اللذين امتاز بهما عالم الغرب، فقد رافق ذلك تطور هائل في أنظمة الاتصال الجماهيرية -السلكية واللاسلكية- حتى عاد العالم كأنه قريةٌ واحدةٌ، انعدم فيها عاملُ الزمن، وانخفض إلى درجة الصفر، فعبرَ برهةٍ من الزمن تُنقلُ المعلومة والصورة حيَّتين من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وتُخزن المعلومات الكثيرةُ وتُستدعى في لحظات.
وقد أفرز هذا الوضعُ التقنيُ الحديثُ حاجةُ عند جماهير الناس تدفعهم نحو الاستمتاع بهذه الأنظمة، والاستفادة من خدماتها، في الوقت الذي استغلت فيه شركات الإعلام، والقوى الرأسمالية العالمية من خلفها هذه الوسائل التقنية المتنوعة بكفاءة عالية، لتبث من خلالها ما يحققُ أهدافها الاستعمارية، وغاياتها التسلطية على شعوب العالم المستضعفة، من خلال الكلمة المكتوبة، والفكرة المسموعة، والصورة المنقولة.
ولقد كان للأمة المسلمة المعاصرة النصيب الأكبرُ من هذه الهجمة التقنية الحديثة، التي اصطلح المفكرون الإسلاميون على تسميتها بالغزو الفكري، واصطلح الإعلاميون على تسميتها بالغزو الإعلامي، فقد تزامنت هذه الهجمةُ الإعلاميةُ مع تخلفِ المسلمين الحضاري، وتفرقهم السياسي، مما جعل أثرها في الأمة أبلغ، وتحقيق غاياتها آكد.
ورغم ما تحملُهُ هذه الوسائلُ الإعلاميةُ المعاصرة -ولاسيما المرئية منها- من إيجابيات ثقافية، فإنها إلى جانب ذلك تحمل معها كمّاً هائلاً من مظاهر الانحرافات العقدية والخُلقية، التي تُعدُّ جزءاً أصيلاً من مكونات الرسالة الإعلامية المعاصرة، مما يهدد الأمة المسلمة في أصولها الكبرى، ومُثلها العُليا، ومبادئها التي تعتز بها.
وبظهور الفضائيات وشبكات الإنترنت، وتوافرها بسهولة ورخص ثمنها للمستهلكين زاد خطرُ الهجمةِ الإعلامية من حيث صعوبة الانتقاء الإيجابي من جهة، واستحالة الانعزالِ السَّلبي من جهة أخرى، فأصبح تأثيرُ هذه الوسائل يصل إلى كلِّ متلقٍ أيّاً كان موقعُهُ من العالم، وأيّاً كانت ثقافته ومعرفته، يطَّلعُ الناسُ جميعاً - كباراً وصغاراً، وذكوراً وإناثاً، ومتعلمين وأميين - دون استثناء على كل ما يُذاع ويُشاهد فلم تعد الحدود الدوليةُ، والحجُب الاجتماعية، والعاداتُ المرعيةُ تحولُ دون بلوغ الرسالة الإعلامية مداها الإنساني، لتصب مضامينها الثقافية والفكريةَ في المستقبلين، وتُسهمَ بالأسلوبين -المباشر وغير المباشر- في تكوين الشخصية الإنسانية العالمية، التي يجتمع في فكرها وسلوكها ما تشتت بين الثقافات، وينصهرُ في ذاتِها ما تفرَّقَ بين الشعوب والجماعات.
وذلك في الوقت الذي عَجَزَت فيه وسائل الإعلام الإسلامية المعاصرةُ عن مزاحمةِ الكبارِ برسالتها الإعلاميةَ العالمية، فلم تجد لها موقعاً في فضاء الدنيا الفسيح، وضاقت بها موجات الأثير، وكان قدَرُها الوحيدُ أن تعيش منطوية تحت سطوة غيرها، تتطفَّلَ على فتات موائدهِ الثقافيةِ، وأطروحاته الفكرية، تجتر من فضلاته، وتستقي من كُدُراته حتى أصبحت ظلاً ذليلاً لكلِ صورة، تتشكل بشكلها، وتتَّصفُ بوصفها، لا تميُّزَ ولا استقلال، ولا عطاء ولا إبداع، همُّها التقليدُ والمُحاكاة، والتشبُّهُ والمُجاراة.
ولقد كان لهذا الوضع الإعلامي المتردي آثارُهُ البشعة في تشويه الشخصية الإسلامية بوجه عام، وتغيير معالمها المتميزة، ولاسيما شخصية الناشئة من شباب الأمةِ الإسلامية، فقد حازَ الشَّباب على النصيب الأكبر من التأثير السَّلبي للإعلام المعاصر، سواء كان عن طريق الإعلام العالمي المُسيطر، أو الإعلام المحلي المُقلِّد، وانفَردت - في كل ذلك- الوسائل الإعلامية المرئيةُ بالساحةِ الإعلاميةِ الأوسع، واختصّت بالفئاتِ الاجتماعيةِ الأكثر.
والمرأة المسلمةُ على العموم، والفتاةُ على وجهِ الخصوصِ لم تكن لتعيشَ منعزلةَ بشخصيتها ضمنَ هذا الوسطِ الثقافي المتفاعل، حتى خاضت فيما خاضَ فيه المجتمع، ونهِلَتْ ممّا شربَ منه الناس، فما كان التأثيرُ السَّلبي ليفوتَها وقد أثر في المجتمع، حتى غدت فئاتٌ كبيرةٌ من النساءِ المسلمات، والفتياتِ الشاباتِ صورةً مكررة للمرأة في النموذج الغربي، لا فرق يُميِّزهُن إلا ما تفرضُهُ الوراثةُ بالفطرة من الأشكال والألوان، ها هو العالم الغربي اليوم يُجهز على البقية الباقية من خير في نساء الأمة، ليصوغََ المنظومةَ الاجتماعيةَ العربيةَ من جديد، في ضوءِ مفاهيمه الخَرِبة، وأفكاره العفِنة، ونُظُمه الاجتماعية المتهالكة، حتى إن العالم يجتمع لمرّات مُتعددة، عبر سنواتٍ متلاحقة، يناقشُ قضايا الإناث، وأحوال النساء، من خلال مؤتمرات عالمية، وتجمعات إقليمية: انبثقَ عنها جمعٌ كبيرٌ من الاتفاقيات والوثائق والتوصيات، التي تأخذُ مكانها للتطبيق في دول العالم، مخترقة بذلك مختلف الأعرافِ والثقافات، والنحلِ والعادات، لتصُبَّ الناسَ أجمعين، على اختلاف مذاهبهم، وتنوُّع مشاربهم، في قالب من الوَحدةِ الثقافية العالمية، تنصهر فيه العقائد والتصورات، وتذوب فيه المفاهيمُ والمعتقدات في وقتٍ حُجب فيه الإسلام، بمنهجه التربوي المتكامل، ورحمتِهِ الواسعة، وراء أمةٍ متخلفة مُبعثرة، تمارس في واقعها المعاصر، سلوك الصَّد عن سبيل الهدى، وفتنةَ الخلقِ عن نهج الحق.
إنَّ أمّة الإسلام لم تُخلقْ لتكون ظلاً لغيرها، وإنما خلقت لتكون شاهدة على الناس، خُلقت لتقود وترأس، وتُعطي وترحم، إنَّ أمّة الإسلام لم تُوجد قطُّ لتكون ذنباً في ركب الحضارة، وإنما وُجدت لتكون رأسا في الحياة، وعموداً للدنيا.
ولْتعلمِ الدنيا بأنا أمة خُلقت لحفظ كرامة الإنسان
لقد خصَّ الله تعالى هذه الأمَّة بفضائل عظيمة، وآلاء جسيمة، حتى رفع مكانها، وأظهر سلطانها، وأعزَّ جنابها، فكانت بحق أمَّةَ القيادة والسيادة أسبغ عليها من النِّعم الكثيرة، وفتح لها من الكنوز ما هو عظيم، حتى أصبحت منبعَ الخير، وعَلَمَ الهدى، ونور الدنيا، فاهتدى بنورها الضالون، واستبصرَ بهداها الغافلون، واستبان بحجتها الحائرون، ثم هي اليوم في ظل العولمة المتسلطة، وتحت سلطان الأمم الكافرة يُراد لها أن تعيش بغير ثقافتها، وتحيا بغير عقيدتها، وأن تموت في سبيل غيرها، وترضى بالدَّنيةِ في دينها، وبالذل في كرامتها، وبالمهانة في عزتها، فعقيدتها يلُوكُها الملاحدةُ المرتدون، وشريعتها ينالُ منها الظالمون، وأرضُها يطؤها الكافرون، فدينُ الأمّة مستباحٌ مغلوب، وحُرمةُ نفس المسلم مُنتهكة مُهدرة، وعقلُهُ معطل مشلول، ونسله ضائعٌ مخدوع، ومالُهُ ملوث منهوب.
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان
ماذا بقي للأمة من دينها بعد أن حُرمت من رحمة شريعتها،وأصبحت تسمعُ عبرَ موجات الأثير مسبة دينها، واستنقاصَ شريعتها، والاستهزاء بعقيدتها، ثم ماذا بقيَ للأّمة من حُرمةِ شعوبها، وعزةِ أوطانها، بعد أن وَطِئَها المستعمرون، وماذا بقي للأمة من عقول رجالها بعد أن أنهكتْها الخمورُ والمخدِّرات، واستحكمت فيها التوافهُ والمُحقرات، ثم ماذا بقي للأمة من قوة شبابها بعد أن غزاهُ الإعلام بالصورة الخليعة، والكلمة الساقطة، والنغمة الماجنة، وبعد ذلك ماذا بقي للأمة من قوتها الاقتصادية، بعد أن تلوثت ثرواتها بالمُحرمات، ونُهبت أموالها بالخداعات، وانتهكت حقوقها بالاحتكارات.
لقد نجح الغربُ من خلال مؤسساتهِ المُتسلطة في تهميش دور الأمة وعزلها بالكلية عن صناعة الحياة المعاصرة، والإسهام في بناء الحضارة الحديثة، لتعيش عالةُ على المجتمع الدولي: تأكل ممّا يُنتجُهُ غيرها، وتلبَسُ مما يصنعُهُ غيرها بل وتنظر بِفَهم غيرها، وتكرر من خلالِ وسائلِ إعلامها القاصرة ما يبثُّهُ غيرها، دون أن تكون للأمة شخصيتها المتميزة، وطبيعتها المتفردة، ومن المعلوم أنَّ أمّة بلا إعلام كجسدٍ بِلا لسان.
ولئن جاز للأمة -في زمن تخلفها- أن تستورد الطعام واللباس، فإنه لا يجوز لها أن تستورد الثقافة، فإنَّ الثقافة خاصية أممية، والأمة الإسلامية -دون سائر الأمم- لا تقبلُ ثقافتها الشركة، فإماّ أن تكون إسلامية، أو أن لا تكون إسلامية، فأيَّةُ خيانةٍ تمارسها الأمةُ اليوم، حين تُقدم لشعوبها ثقافة أجنبية، تتعارض مع أصولها وأخلاقها ومبادئها؟
لقد حالت الأميةُ في الزمن الماضي دون وصول الفكر الدخيل إلى كثير من أبناء الأمة، وأمّا اليوم، وبعد التفوق المذهل لوسائل الإعلام الحديثة، تساوى الأميون مع المتعلمين في استيعاب الرسالة الإعلامية، وأصبحت حمايةُ المخدّّرات في البيوت أمراً يكاد يكون مستحيلاً، فلم تعد الجدرانُ والستورُ والحُجبُ لتكفَّ هذه الوسائلَ عن الوصول بمضامينها المنحرفة إلى كلّ أفرادِ الأمة، من الصغار والكبار، ومن الذكور والإناث، تصوغُ أفكارهم، وتنتزعُ أخلاقهم.